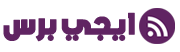باكستان.. أزمة كشمير تساعد الجيش في تعزيز هيمنته على النظام السياسي

في 20 مايو، وللمرة الثانية في تاريخ باكستان الممتد لـ 77 عامًا، رُقّي قائد عسكري في الخدمة إلى رتبة مشير مرموقة. بالنسبة للجنرال سيد عاصم منير أحمد شاه، كانت هذه الترقية تتويجًا لطموحاته وتأكيدًا رمزيًا على هيمنة الجيش في النظام السياسي الهش في البلاد.
وأكد تقرير صدر مؤخرا عن مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية أن أزمة كشمير الأخيرة بين نيودلهي وإسلام آباد أكدت وعززت قبضة الجيش على النظام السياسي في باكستان.
وبحسب التقرير، فإن باكستان كانت منذ فترة طويلة دولة بريتورية تقليدية: وهو نظام سياسي تكون فيه المؤسسات السياسية ضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع احتواء أو توجيه قوة الجيش، الذي يعمل في كثير من الأحيان باعتباره القوة الموحدة الوحيدة للحفاظ على النظام.
في التقرير، يشير أبارنا باندي، مدير مبادرة مستقبل الهند وجنوب آسيا في معهد هدسون، وفيناي كورا، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية ودراسات الأمن في جامعة سردار باتيل للشرطة والأمن والعدالة الجنائية في راجستان بالهند، إلى أن هذا النمط ليس مصادفة، بل هو نتيجة لدولة تشكل حمضها النووي المؤسسي (جوهرها) في ظل المركزية الاستعمارية، والتي توقف تطورها السياسي قبل ترسيخ المعايير الديمقراطية بقوة.
لم يكن صعود الفريق منير إلى رتبة مشير مجرد صعود ضابط عسكري، بل ذروة نظام. وتُجسّد مسيرته المهنية – التي شملت قيادة كلٍّ من الاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات الرئيسي في باكستان – اندماج المراقبة والرواية الدينية والقيادة الاستراتيجية التي تُميّز الجيش الباكستاني اليوم.
وهذه القوة لم تعتبر قط أن مهمتها الأساسية هي حراسة حدود باكستان، بل حماية الحدود “الأيديولوجية” للبلاد.
يجادل باندي وكاورا بأن النخبة المؤسسة للدولة الجديدة – التي تأسست كديمقراطية – حافظت على هيكل السلطة الاستعمارية وخصائصه. كان من شأن التركيز المتزايد على التوازن المؤسسي أن يؤدي إلى باكستان يملأ فيها التماسك التنظيمي للجيش الفراغ الذي خلفته الأحزاب السياسية الضعيفة، والبيروقراطيات المتجذرة، والبرلمانات التي فقدت مصداقيتها، والقضاء المُسيّس.
على مدى 77 عامًا مضت، ظل الجيش الباكستاني يُخفي أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الحكومة تحت ستار الحفاظ على النظام القائم. وحتى اليوم، وفي ظل حكومة مدنية اسميًا، لا يقع مركز السلطة في البرلمان بالعاصمة إسلام آباد، بل في قاعات راولبندي المحصنة، حيث مقر القيادة العسكرية.
ويرى باندي وكاورا أن باكستان مبنية على هذا التناقض غير المستقر الذي لا يمكن الدفاع عنه، حيث يدعي مركز واحد الشرعية بينما يمارس مركز آخر هذه الشرعية. تستند شرعية الجيش إلى وهم النظام والاستقرار. وبإظهاره صورةً من ضبط النفس والهدف الوطني، يتهرب الجيش من أي مسؤولية، رغم ضعف المؤسسات المحيطة به.
لقد نسي الجيش أو تجاهل أن كل دولة تتطلب تعاون مؤسساتها المختلفة ضمن نظام موحد. ولن يتمكن الجيش من إدارة جميع شؤون باكستان، حتى وإن حاول ذلك بانتظام، أحيانًا علنًا، ودائمًا سرًا.
ويرى باندي وكاور أن التدخلات العسكرية المفرطة لم تجعل من باكستان دولة قوية بل دولة هشة: فالمجتمع الباكستاني مجزأ على أسس عرقية ولغوية، والنظام السياسي في البلاد أجوف ومتطرف، والاقتصاد راكد.
يُذكرنا لقب المشير بأيوب خان، رجل الدولة العسكري النموذجي، الذي رافق عهده إضفاء الطابع المؤسسي على الحكم العسكري. وبينما أظهر خان سلطته بوضوح وصراحة – فقد أصبح قائدًا للجيش عام ١٩٥١، ثم رئيسًا في انقلاب عام ١٩٥٨، وحكم حتى استقالته عام ١٩٦٩ – فإن سلطة منير شاه، المشير اليوم، تكمن في تناقضها: فالجيش الباكستاني الحديث لا يُسقط الحكومات المدنية – بل يُنصّبها؛ ولا يُلغي الانتخابات – بل يتلاعب بنتائجها؛ ولا يمارس رقابة علنية – بل يُروّج لروايات مُختلفة.
المأساة لا تكمن في القطيعة، بل في الاستمرارية التي تتخفى في صورة الإصلاح. لم يتغير موقف الجيش تجاه المعارضة الداخلية، سواءً أكانت تمرد البلوش أم مطالب البشتون والسند بحقوقهم. لا تُفهم هذه المطالب في بلد يتميز بتنوعه العرقي واللغوي، بل تُعتبر خيانةً مدعومةً من قوى خارجية، وخاصةً الهند وأفغانستان.
إن ردّ الجيش على أيِّ مظهرٍ من مظاهر المعارضة ليس المشاركة، بل الإقصاء. وقد شرعنت المحكمة العليا هذا الأمر بموافقتها على اختصاص القضاء العسكري على المدنيين، وهو تطبيعٌ مُقلقٌ للفقه الاستبدادي.
هذا جزء من نمط أوسع: خلال عهد منير، توسّعت التدخلات العسكرية في الصحافة والقضاء والانتخابات. في هذا المناخ، أُعيد تعريف السيادة: ليست سيادة شرعية قائمة على القانون، بل سيادة سياسية قائمة على القوة.
في كل دول العالم، الدولة هي المؤسسة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة. فبمجرد أن تسمح دولةٌ ما لأطرافٍ غير حكومية باستخدام الأسلحة، فإنها تتخلى عن شرعيتها لصالح مصالحها قصيرة الأجل.
منذ عام 1947، وخاصة منذ سبعينيات القرن العشرين، اعتمد الجيش الباكستاني على الجماعات الجهادية كأداة لسياساته الخارجية الإقليمية، وخاصة تجاه الهند وأفغانستان.
ونظراً للمخاوف من عدم قدرة باكستان على الحفاظ على تفوقها العسكري التقليدي على الهند، وخاصة بعد عام 1971، فقد وسع الجيش الباكستاني سياسة الردع لتشمل مستويين: الأسلحة النووية والحرب شبه التقليدية أو الحرب بالوكالة.
وفي حين أدت الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعات باكستانية في الهند إلى مقتل وإصابة أشخاص أبرياء، فإن ردود الفعل ضد باكستان والباكستانيين كانت أسوأ.
في عام 2011، حذرت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون نظيرها الباكستاني، قائلة: “لا يمكنك أن تحتفظ بالثعابين في حديقتك الخلفية وتتوقع منها أن تعض جيرانك”، مؤكدة بذلك على الأوهام القاتلة التي تعيشها الدول التي تعاني من وحوش من صنعها.
أصبحت مناورات الجيش الباكستاني مع وكلائه لتعزيز وجوده الإقليمي خطرًا استراتيجيًا. ينظر كثيرون حول العالم إلى باكستان كملاذٍ للإرهابيين. وبينما قد يرفض السياسيون الباكستانيون المحليون هذا الأمر باعتباره دعاية غربية أو هندية، سيُضطرون عاجلًا أم آجلًا إلى مواجهة الواقع.
يخلص باندي وكاورا إلى أن لا شيء مُقدّر، وأن الدول تتعثر، أحيانًا بشكل كارثي، لتجد في داخلها القدرة على التجديد. بعد سبعة وسبعين عامًا من تأسيس باكستان كدولة ديمقراطية، يتعين على القادة السياسيين في البلاد إعادة النظر في مسارهم المستقبلي. إما أن يتعمقوا في الحكم العسكري أو يعودوا إلى الفيدرالية الدستورية.