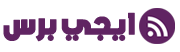هل تصمَم المنتجات كي لا تدوم طويلاً؟

توقفت سماعات أذني عن العمل تمامًا، رغم أنني لم أستخدمها إلا منذ عام. باءت جميع محاولات إصلاحها بالفشل. كان أداء هاتفي يتدهور ويحتاج إلى شحن مستمر. توقفت ثلاجتي، التي يبلغ عمرها عامين، عن العمل، وكلفني إصلاحها فنيٌّ لدى الوكيل “المعتمد” مبلغًا كبيرًا. ناهيك عن انتظاري لمدة أسبوعين للحصول على قطعة غيار في خضم موجة حر شديدة. يا له من حظ عاثر؟
أثناء زيارتي لوالدتي مؤخرًا، لاحظتُ ماكينة الخياطة التي اشترتها منذ أكثر من أربعين عامًا. لا تزال تعمل بكفاءة عالية، ويتطلب حملها جهدًا بدنيًا كبيرًا. المروحة الصفراء، التي يزيد عمرها عن ثلاثين عامًا، لا تزال تُضفي نسيمًا باردًا في أيام الصيف الحارة. الثلاجة وموقد الغاز والأجهزة الأخرى جميعها بحالة جيدة رغم قدمها، بينما الأجهزة التي يتجاوز عمرها عشر سنوات نادرة في منزلي.
إذن، ما الذي يحدث؟ هل يُصمّم المُصنّعون منتجاتٍ ذات عُمرٍ قصير؟ لماذا يصعب إصلاح بعض الأجهزة؟ هل يُمكن تفسير ذلك بما يُسمّى “التقادم المُخطط”؟ هل نُسارع الآن إلى استبدال ممتلكاتنا، حتى لو لم تكن معيبة؟ وما تأثير ذلك على البيئة؟
مشكلة الضوء الكهربائي
في بداية القرن العشرين، عانى أعضاء اتحاد فويبوس كارتل، وهو اتحاد لمصنعي المصابيح، من طول عمر مصابيحهم. ولزيادة المبيعات، قرروا تقصير عمرها الافتراضي إلى 1000 ساعة في المتوسط. وتعرضت الشركات التي تنتهك هذه “المعايير” لغرامات.
وعلى الرغم من أن اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939 كان بمثابة نهاية الاتحاد، لأنه جعل المزيد من التعاون بين أعضائه مستحيلاً، إلا أن هذا لم يغير الطريقة التي تم بها تصنيع المصابيح التقليدية.
هذا مثال على التصميم المتعمد للمنتجات قصيرة العمر. ووفقًا لمصادر عديدة، استُخدم مصطلح “التقادم المخطط” لأول مرة عام ١٩٣٢ من قِبل وكيل العقارات الأمريكي برنارد لندن في مقال بعنوان “إنهاء الكساد من خلال التقادم المخطط”. كان اقتراح لندن يهدف في الأصل إلى تحفيز الاقتصاد، وإنهاء الكساد، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الناس على شراء سلع جديدة بدلًا من القديمة. وقد أعرب عن أسفه لقلة الطلب على المنتجات الجديدة “لأن الناس يتمسكون بأشيائهم القديمة والبالية لفترة طويلة”. ومع ذلك، تطورت الفكرة وأصبحت ممارسة يستخدمها المصنعون لزيادة الأرباح.

الاستهلاكية و”هندسة المستهلك”
قد يبدو التبادل المستمر للسلع والمنتجات، وكذلك شراء الأشياء غير الضرورية، أمرًا طبيعيًا اليوم، لكن الأمور كانت مختلفة في الماضي. كانت المواد الخام أغلى ثمنًا، ويتطلب إنتاجها وقتًا وجهدًا كبيرين، وكان التوفير ومنع الهدر يُعتبران من الفضائل.
انتشرت ثقافة الاستهلاك ومفهوم الاستهلاك الجماعي في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي، واشتدت بعد الحرب العالمية الثانية. فالمنتجات التي كانت متاحة سابقًا لعدد محدود من الناس نظرًا لارتفاع أسعارها وندرتها، أصبحت الآن في متناول الطبقة المتوسطة.
كان الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أسرع من نمو السكان، وكان عرض السلع يفوق الطلب العام. واجه قادة الأعمال خيارين: إما خفض الإنتاج أو زيادة الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي. فاختاروا الخيار الثاني.
صاغ خبير الإعلان الشهير إرنست إلمو كالكنز مصطلح “هندسة المستهلك”. ويشير هذا المصطلح إلى الأساليب المستخدمة للتأثير على سلوك المستهلك بهدف زيادة الطلب على السلع والخدمات وتعزيز الاستهلاك. ويشمل ذلك ما يُعرف بـ”التقادم الاصطناعي”. لعقود، غمرتنا الإعلانات بسيل من الإغراءات التي تحثنا على شراء أحدث الموديلات والصيحات، في محاولة لإقناعنا بأن الإصدار الجديد من المنتج أفضل من سابقه. وقد أدى هذا إلى ترسيخ ثقافة الهدر وعقلية التخلص من المنتجات.

لماذا أصبحت مدة صلاحية العديد من المنتجات أقصر فأقصر؟
زيادة المبيعات والأرباح ليست السبب الوحيد. أحيانًا يتعلق الأمر أيضًا بإنتاج منتجات خفيفة الوزن أو صغيرة الحجم. قد يعني هذا اختيار مواد أقل متانة وعمرًا أقصر.
إن خفض التكاليف من خلال استخدام مكونات أقل جودة أو من خلال الاستعانة بمصادر خارجية يمكن أن يلعب دورًا أيضًا.
لكن هل يقوم المصنعون بتصميم منتجاتهم بطريقة تجعل مدة صلاحيتها قصيرة؟
يقول جوش ليبوفسكي، أستاذ الجغرافيا في جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند بكندا، والذي ألّف عدة كتب عن التجارة العالمية في النفايات الإلكترونية وآثارها البيئية والصحية: “هذا سؤال صعب. من الناحية القانونية، يجب إثبات أن الشركة المتهمة بالتقادم المخطط قد فعلت ذلك عمدًا، وهذا ليس بالأمر السهل”.
يضيف ليبوفسكي: “لا شك أن نماذج أعمال العديد من العلامات التجارية تعتمد على شراء العملاء لأجهزة جديدة، حتى لو كانت أجهزتهم الحالية سليمة من الناحية التقنية. من منظور بيئي، يُعد الجهاز الذي تملكه بالفعل هو الأكثر استدامة. كلما طالت مدة استخدامه، زادت الطاقة والمواد التي توفرها في إنتاجه. في نموذج الأعمال الموجه نحو النمو، هناك حافز لتقصير عمر الجهاز، مما يزيد من متطلبات الطاقة والمواد لإنتاج نماذج جديدة.”

“الحق في الإصلاح”
غالبًا ما يُضطر المستهلكون، وخاصةً في الدول الغنية، إلى شراء منتج جديد بدلًا من إصلاح القديم، نظرًا لتكلفة الإصلاحات أو استحالة الحصول عليها، أو لندرة قطع الغيار أو الأدوات، خاصةً للأجهزة الإلكترونية. هذا يُسهّل أو يُخفّض تكلفة شراء منتج جديد، مما يؤدي بدوره إلى استهلاك مفرط للموارد وزيادة النفايات الإلكترونية.
كان هذا هو السبب الرئيسي لظهور حركة “الحق في الإصلاح” في الولايات المتحدة. تدافع هذه الحركة عن حق المستهلكين في إصلاح منتجاتهم بأنفسهم أو طلب إصلاحات مستقلة. الهدف هو تعزيز الاستدامة ومكافحة ثقافة التقادم المخطط له.
اكتسبت هذه الحملة زخمًا في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وانتشرت في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل التعقيد المتزايد في تصميمات الأجهزة الإلكترونية، التي تحتوي الآن على مكونات مملوكة حصريًا للشركة المصنعة أو تحتوي على أقفال برمجية وقيود رقمية أخرى تمنع الإصلاح بواسطة طرف ثالث.
قال البروفيسور أليكس سيمز، أستاذ القانون التجاري بجامعة أوكلاند بنيوزيلندا، لبي بي سي عربي: “لا يقتصر حق الإصلاح على المنتجات المعيبة، بل يمتد ليشمل استخدامها أيضًا. واليوم، أصبحت العديد من المنتجات مزودة ببرمجيات مدمجة تمنع استخدامها كليًا أو جزئيًا – على سبيل المثال، الطابعات التي تتوقف عن العمل إذا لم تدفع الاشتراك. أو سيارات تيسلا التي لا تسحب مقطورة إلا باستخدام قضيب سحب معتمد”.
تضم الحركة حاليًا عشرات المنظمات غير الحكومية والجماعات التي تطالب بتشريعات تُعزز الحق في الإصلاح. وقد نجحت بالفعل في إقناع الهيئات التشريعية في عدة ولايات أمريكية والاتحاد الأوروبي بسن مثل هذه القوانين واللوائح. كما تنشر أدلة إصلاح إلكترونية مجانية لمجموعة واسعة من المنتجات، من الملابس إلى الإلكترونيات، ومن السيارات إلى المعدات الطبية، وغيرها الكثير. ومن بين المواقع الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمات: IFixit وThe Restart Project.
وقد واجهت هذه الحركة مقاومة من جانب الشركات المصنعة وبعض جماعات المستهلكين، مع التركيز في المقام الأول على المخاوف المتعلقة بالسلامة وحقوق الملكية الفكرية.
يقول سيمز: “القلق الرئيسي هو سلامة الإصلاحات غير المصرح بها. ومع ذلك، فقد حققت لجنة الإنتاجية الأسترالية في هذا الأمر ووجدت أنه لا يوجد خطر متزايد. في الواقع، في بعض الحالات، قد يكون حظر الإصلاحات غير المصرح بها أكثر خطورة، لأنه يشجع الأشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة أو التدريب اللازم على محاولة الإصلاح بأنفسهم. من المهم ملاحظة أن بعض المنتجات تتطلب إصلاحات احترافية، لكن الكثير منها لا يتطلب ذلك”.
تكاليف بيئية عالية
تُشكّل النفايات الإلكترونية مشكلةً كبيرةً لاحتوائها على موادّ تُضرّ بالبيئة وصحة الإنسان إذا لم يتمّ التخلص منها بشكل صحيح. ويؤدي قصر عمر المنتجات والرغبة المُستمرة في اقتناء موديلات أحدث وأكثر أناقةً إلى زيادة هذه النفايات. ويلجأ بعض تجار التجزئة، وخاصةً في قطاعي الإلكترونيات والأزياء، إلى التخلص من المنتجات ذات العيوب البسيطة بدلاً من إعادة بيعها بأسعارٍ أقل. كما يتخلصون من المنتجات التي لم تُبع لعدم احتفاظها بقيمتها وحصريتها، أو لكونها الخيار الأرخص.
ويقول البروفيسور ليبوفسكي: “في الوقت الحالي، يتم إنتاج أجهزة أكثر مما يمكن بيعه”، مضيفًا أن تقديرات الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن تجار التجزئة يدمرون إلكترونيات جديدة بقيمة مئات الملايين من الدولارات كل عام.
وأضاف أن أحد الحلول الممكنة هو “إلزام الشركات بتوزيع المعدات الفائضة على المؤسسات العامة مثل المكتبات”.
بدأت بعض العلامات التجارية للأزياء ببيع منتجاتها الفائضة إلى متاجر الخصم، أو التبرع بها للجمعيات الخيرية، أو إعادة تدويرها.
يؤكد البروفيسور سيمز: “مقارنةً بإعادة التدوير، يُعد إصلاح المنتجات أكثر كفاءةً في استخدام الموارد، ويحمي الكوكب، ويحمي صحة العاملين في مراكز إعادة التدوير. للأسف، هناك من يُفرط في الاستهلاك ويشتري أجهزة جديدة رغم أن أجهزته لا تزال تعمل بكفاءة. لو تبرعوا بمنتجاتهم القديمة أو باعوا ثمنها، وكان من الممكن إصلاحها بتكلفة منخفضة، لقلّت مشترياتهم الإجمالية من السلع.”
إن قصر عمر المنتجات مقارنةً بالماضي ليس مجرد سوء حظ، بل هو نتيجة نظام استهلاكي قائم على الاستبدال السريع والابتكار المستمر. من أجل مستقبل أكثر استدامة، يجب على المصنّعين تطوير منتجات قابلة للإصلاح وتدوم لفترة أطول، ويجب على المستهلكين إعادة النظر في مشترياتهم، وضرورتها الفعلية، وتأثيرها على البيئة والصحة.