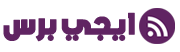الاحتفال بتوقيع كتاب ابن تغري بردي بالأعلى للثقافة

في إطار مبادرة “تراثك إرثك”، استضاف المجلس الأعلى للثقافة حفل توقيع كتاب “ابن تغري بردي وكتاب النجوم المضيئة لملوك مصر والقاهرة” للدكتور محمد محمد مغاوري.
أدار الندوة الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامي وخبير المخطوطات. وشارك في الندوة كلٌ من الدكتور أشرف أنس، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة المنصورة؛ والدكتورة سحر سيد دسوقي، باحثة في التاريخ الإسلامي؛ والدكتور عمرو منير، أستاذ التراث الثقافي والتاريخ الوسيط بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي وعضو لجنة التراث الثقافي غير المادي والفنون الشعبية.
افتتح النقاشَ مديرُ الجلسة الدكتور أيمن فؤاد، موضحًا أن كتاب “النجوم المضيئة لملوك مصر والقاهرة” موسوعةٌ تاريخيةٌ شاملةٌ كتبها المؤرخ المملوكي جمال الدين يوسف بن تغري بردي في القرن التاسع الميلادي. ويُعتبر من أهم المصادر في تاريخ مصر الإسلامية منذ الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوكي. يضم الكتاب سير الحكام والولاة والسلاطين، جامعًا بين سردٍ زمنيٍّ للأحداث وتحليلٍ شخصيٍّ، ليُقدم نظرةً شاملةً على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية المصرية. يعكس المؤلف في هذا الكتاب انتمائه إلى دوائر الحكم ورؤيته الخاصة للتاريخ، مما يجعل هذا العمل ليس مجرد تاريخٍ للملوك، بل وثيقةً تكشف عن طبيعة السلطة والخطاب التاريخي في عصره.
ثم تحدث الدكتور أشرف أنس، موضحاً أن اللافت في كتاب “الكواكب المضيئة لملوك مصر والقاهرة” للمؤرخ المملوكي ابن تغري بردي، والذي يعد من أهم المصادر التاريخية لتاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى نهاية القرن التاسع الميلادي، هو التوثيق الدقيق والملاحظات الشخصية للمؤلف، والتي تكشف عن وجهة نظره الفريدة للأحداث والشخصيات.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الكتاب يتميز أيضًا بالتناقض الواضح بين ولائه للسلطة ونقده الضمني. فهو يُبجّل السلاطين ويُشيد بإنجازاتهم، لكنه لا يتردد في إدانة الثورات والاضطرابات والانهيارات داخل الدولة. لذا، فإن “النجوم اللامعة” أكثر من مجرد سجل؛ فهو يعكس وعي مؤرخ عاش في قلب السلطة وكتب التاريخ انطلاقًا منها. وهذا ما يجعله مادة ثرية لتحليل نقدي للعلاقة بين المعرفة التاريخية والسلطة، وكذلك بين الرواية الرسمية والواقع المعاش.
ثم تحدثت الدكتورة سحر سيد دسوقي، موضحةً أن كتاب “النجوم اللامعة” ليس مجرد مرجع تاريخي ضخم، بل هو ذاكرة مصرية خالصة، تؤرخ لما يقرب من خمسة قرون من تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني، بدءًا من الفتح الإسلامي وحتى أواخر العصر المملوكي. ورغم طوله، لم يحظَ هذا النص بالقراءة النقدية والتحليل البنيوي والاهتمام المنهجي الذي يستحقه. وهنا تكمن أهمية الكتاب المعروض علينا اليوم. فقد قدم الدكتور مغاوري قراءة نقدية متوازنة تكشف عن المنهج التاريخي لابن تغري بردي، وتوجهاته الثقافية، ومصادره، وميوله، بل وحتى انحيازاته. وهذا يُتيح لنا رؤية شاملة للنص، ومؤلفه، وسياقه.
وتابعت، مشيرةً إلى أن هذا الكتاب يُعمّق في البنية الأسلوبية لرواية “النجوم اللامعة”، ويدرس لغتها ومصطلحاتها، بل ويستكشف معالجة المؤلف للأحداث السياسية وشخصيات السلاطين. كما يُبرز الكتاب التفاعل بين التاريخ والسيرة الذاتية والخطاب الملكي. وفي الختام، أكدت أن هذا النوع من الدراسات لا يُحيي النصوص القديمة فحسب، بل يُعيد تشكيل وعينا بها، ويُعلّمنا قراءة التراث كحركة فكرية تُثير الفهم والنقد. وقد نجحت الكاتبة في تقديم النص إلينا ليس كأثرٍ من الماضي، بل كوثيقةٍ حيّةٍ تُثير تساؤلاتنا الراهنة.
علق الدكتور عمرو منير لاحقًا قائلاً: “هذا الكتاب ليس مجرد سرد لحياة ابن تغري بردي أو فهرس لأعماله، بل هو دراسة شاملة تحاول تفكيك البنية الفكرية والتاريخية لكتاب “النجوم اللامعة” في ضوء العوامل التي أثرت على تكوين المؤرخ، ومؤهلاته، ومنهجه، ومكانته في مدرسة التاريخ المصري. كما يحاول إعادة تفسير نواياه التفسيرية، وتقييم مدى موضوعيته، دون اللجوء إلى التمجيد أو التشهير.
وأشار إلى أن الجهد الملحوظ المبذول في تحليل محتوى “النجوم اللامعة” لا يقتصر على المنظور السياسي فحسب، بل يتناول أيضًا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي مواضيع أُهملت طويلًا في دراسات مؤرخي المماليك. يسد هذا الكتاب ثغرة مهمة، ويتيح لنا قراءة أكثر تعقيدًا لنص ابن تغري. وإذا أردتُ تلخيص انطباعي العام عن هذا الكتاب، فسأقول إنه يساعد في إعادة تقديم “النجوم اللامعة” ليس كموسوعة تاريخية فحسب، بل كوثيقة إثنوغرافية عن الدولة والمجتمع والسلطة في العصر المملوكي. إنه يمنحنا أداة لفهم كيفية وصف المؤرخ للدولة، ليس كما هي فحسب، بل كيف ينبغي سردها. وفي نهاية محاضرته، تساءل: هل نقرأ التاريخ أم نقرأ المؤرخ؟
وتابع موضحًا أن “النجوم اللامعة” تبدو للوهلة الأولى وكأنها تأريخ لملوك مصر منذ الفتح العربي في نهاية القرن التاسع الميلادي. إلا أن التدقيق يكشف عن خطاب ثنائي: تاريخ رسمي للسلطة وسيرة ذاتية ضمنية لمؤلفها. لا يقتصر ابن تغري على سرد الأحداث، بل يسعى جاهدًا ليكون حاضرًا في النص: بمواقفه، وتقييمه، وتحيزاته، وأحيانًا حتى ملاحظاته الشخصية. هذا يذكرني بملاحظة فلاسفة تفسيريين مثل بول ريكور، وهايدن وايت، وميشيل فوكو، بأن الخطاب التاريخي كله ممارسة استبدادية تُنتج المعرفة وتُقمعها. وهكذا، عندما نقرأ ابن تغري بردي، فإننا لا نقرأ ملوك مصر فحسب؛ بل نقرأه هو نفسه، كما لو كان نصه سيرة ذاتية مُقنّعة وراء قناع التأريخ الرسمي. من الخطأ تفسير ابن تغري بردي على أنه مؤيد للمصالح الملكية. كان ابنًا للبلاط، ابن أميرٍ مُقرّبٍ من أصحاب النفوذ. ومع ذلك، كان أيضًا شاهدًا مُهتمًا، يُوثّق الأحداث بشعورٍ مُتوتّرٍ بالتغيير والانهيار في ذهنه. كتب التاريخ من داخل الحكومة، لا باسمها. وهذا يُثير سؤالًا فلسفيًا: هل التاريخ المكتوب من الداخل أصدق أم أكثر تبعية؟
وتابع: “في “النجوم الساطعة”، نلقي نظرة على هذه الثنائية: فهو يقدس السلطان، ومع ذلك لا يخشى إدانة الفتنة والخيانة والفجور، وكأنه يقول إن الشر يكمن في قلب الدولة، وليس فقط في أعدائها”.
يؤكد مؤلف الكتاب، الدكتور مغاوري، أن المؤرخ ابن تغري بردي (812-874م/1409-1469م) يُعدّ من أهم مؤرخي المدرسة المصرية في التاريخ. عاصر ستة عشر سلطانًا مملوكيًا شركسيًا، واستطاع أن يرسم صورة دقيقة لحياة المماليك وصراعاتهم. استفاد من قرابة قرابة ومصاهرة بعضهم، لا سيما وأن والده كان أميرًا ذا شأن في ذلك الوقت. وقد استطاع ابن تغري بردي وصف الأحداث من منظور شاهد عيان، مما أضفى على كتاباته قيمة علمية كبيرة.