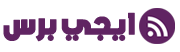ماذا نعرف عن القبائل السوريّة؟ وما علاقتها بالدولة؟

عندما تُستخدم مصطلحات مثل “البدو” أو “الشوايا” أو “قبائل الفلاحين” في نقاشات حول القبائل والعشائر السورية، سرعان ما يندلع الجدل. فبينما تصف هذه المصطلحات ظاهريًا الظروف الاجتماعية أو الجغرافية، إلا أنها تحمل دلالات تاريخية وطبقية معقدة، وترتبط أحيانًا بالتمييز أو التسلسل الهرمي الاجتماعي.
في بعض السياقات، يُنظر إلى مصطلح “بدوي” باعتباره علامة على الأصالة والفروسية العربية، ولكن في سياقات أخرى يتم استخدامه بطريقة هامشية، كما وصفه أعضاء هذا المجتمع لبي بي سي.
وبالمثل، يشير مصطلح “الشاوي” جغرافيًا إلى سكان جميع المناطق الريفية في شمال شرق سوريا. ومع ذلك، في الخطاب العام بين سكان المدن، قد يثير المصطلح دلالات اجتماعية مسيئة، كما أوضح خبراء في العلاقات القبلية مع الدولة السورية لبي بي سي.
أما بالنسبة لمصطلح “المزارع”، فعلى الرغم من ارتباطه بالأرض والعمل، فقد كان يستخدم غالبًا في الأدب القبلي للتمييز بين رجل القبيلة الريفي المستقر ورجل القبيلة “المتنقل بشكل دائم”.
هذه المصطلحات ليست مجرد تعريفات، بل هي مفاتيح لفهم البنية الطبقية والرمزية في سوريا. وتعكس الحساسية التي تُستخدم بها مزيجًا من التاريخ والسياسة والانتماء.
وفي سوريا، تُستخدم مصطلحات مثل “الشوايا” و”البدو” و”الفلاحين” للتمييز بين أسلوب حياة القبائل في المناطق المختلفة.
تشتهر قبيلة الشواية بتربية الأغنام والماعز، وتعيش في المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات في سوريا إلى العراق.
يُقال إن “البدو” وصلوا لاحقًا من شبه الجزيرة العربية، واعتمدوا على رعي الإبل والتجوال في الصحراء الشاسعة. في المقابل، يُشير مصطلح “الفلاحين” إلى القبائل التي كانت تسكن الجنوب، وخاصةً في درعا وحوران، والتي مارست الزراعة وتربية الماشية.
يقول الباحث السوري حيان دخان، المحاضر الأول في جامعة تيسايد في المملكة المتحدة وزميل الأبحاث في مركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز: “إن مصطلح “القبائل العربية” هو المصطلح الشامل لجميع المصطلحات التي ذكرناها، وهو الأقل حساسية وتعقيداً”.
يوضح أن كلمة “شوايا” ارتبطت تاريخيًا بصورة نمطية للتخلف. ويعزو ذلك إلى عدم إلمام مختلف شرائح المجتمع السوري بأفكار وتقاليد بعضهم البعض. ويوضح أن الكلمة اكتسبت معنى جديدًا في سنوات الصراع الأخيرة، “مصحوبة بالشجاعة والصمود في مواجهة النظام”.
أصبحت العلاقة بين هذه القبائل والمدن صراعًا رمزيًا. فالمدن تعتبر نفسها مناطق مميزة، بينما تبنت القبائل الريفية المقاومة وهوية زراعية أصيلة. ويرى أبناء القبائل أنفسهم “يتعرضون لمعاملة ظالمة من نظام البعث بعد الثورة، لأنهم هم من ثاروا على الآلة القمعية”، كما يقول دخان، الباحث المتخصص في ديناميكيات القبائل في سوريا.
من أين أتوا؟ وأين يعيشون؟

استنادًا إلى دراسات غير رسمية، يُقدّر الباحث السوري حيّان دخان أن أبناء القبائل يُشكّلون ما بين 30% و40% من سكان سوريا، الذين يتجاوز عددهم 25 مليون نسمة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات تختلف بسبب النزوح المستمرّ ونزوح طالبي اللجوء الفارّين من الحرب.
ونظراً للتاريخ الطويل لهذه القبائل في المنطقة، وتنوع المناطق والأقاليم التي تنحدر منها، والاختلافات التاريخية في الوصول إلى هذه المناطق، فمن الصعب جداً على علماء الأنساب والأنثروبولوجيا العرب رسم خريطة دقيقة لأصول هذه القبائل.
ولعل أفضل طريقة لفهم النسيج الاجتماعي السوري هي السفر عميقاً في الصحراء الشاسعة، حيث عاشت مجتمعات قبلية، والتي شكلت منذ العصور القديمة وحتى الدولة الحديثة جزءاً لا يتجزأ من نسيج الهوية السورية.
تعود أصول العشائر السورية إلى قبائل عربية هاجرت واستقرت في البادية والفرات وحوران منذ قرون. تمتد جذورها إلى ما وراء حدود الدولة الحالية. شكلت هذه العشائر بنية اجتماعية مغلقة قائمة على روابط الدم والقرابة والأعراف القبلية، مبنية على مفاهيم الكرم والولاء، وغالبًا ما تدفعها الرغبة في الانتقام وحل النزاعات داخل إطارها الخاص.
ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة، فإن الدراسات، وآخرها دراسة مركز جسور للدراسات، تقدر وجود ما بين 25 و40 قبيلة عربية كبيرة في سورية، موزعة على مختلف المحافظات، وتشكل جزءاً كبيراً من النسيج الاجتماعي، وخاصة في الشرق والشمال والجنوب.
تتمتع هذه القبائل بجذور تاريخية ضاربة في القدم، وتنقسم داخليًا إلى مئات العشائر الفرعية. بعضها يحتفظ بهياكله التقليدية، بينما تحول بعضها الآخر إلى مجموعات عائلية نتيجة التغيرات الديموغرافية الناجمة عن سنوات الحرب والنزوح.
استندت الدراسة، التي نشرها مركز جسور للدراسات عام ٢٠٢١، إلى مقابلات مع ٢٨ من زعماء العشائر والخبراء المحليين، دون الاستناد إلى مراجع تاريخية أو أساليب إحصائية دقيقة. ركزت الدراسة على العشائر في الجزيرة السورية (دير الزور، الرقة، والحسكة)، والمنطقة الوسطى (حمص وحماة)، وجنوب سوريا (درعا، السويداء، والقنيطرة). وأظهرت أن العديد من العلاقات العشائرية في مناطق مثل ريف دمشق قد تطورت نحو أشكال عائلية ومدنية.

يُذكر أن التوزيع الجغرافي والبنية الداخلية للقبائل شهدا تغيرًا ملحوظًا خلال سنوات الصراع، ما أدى إلى تراجع النفوذ التقليدي في بعض المناطق، وتحول الروابط القبلية نحو طابع اجتماعي أكثر فردية.
ترتبط بهذه القبائل العديد من العشائر والعشائر الفرعية، مما يجعل البحث في البنية القبلية في سوريا واسعًا ومعقدًا. ومع ذلك، هناك نقص حاليًا في مبادرات التوثيق الدقيقة والمنهجية أو الإحصاءات الحكومية المعترف بها.
وتنشط قبيلة عنزة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب، إلى جانب قبيلة شمر المنتشرة في الحسكة ودير الزور وفي جميع أنحاء الجزيرة السورية.
في شرق سوريا، تُعد قبيلة العكيدات من أهم القبائل، وتتركز في محافظتي الرقة ودير الزور. كما تنشط قبيلة البقارة في الحسكة والرقة ودير الزور. وتتواجد قبيلة الجبور أيضًا في هذه المناطق، ولها حضور قوي في الرقة والحسكة. كما تنتشر قبيلة الدليم في البادية الشرقية ودير الزور.
في وسط وجنوب سوريا، تتواجد قبيلة النعيم في الرقة وحمص ودمشق ودرعا، بينما تتواجد قبيلة بني خالد في حمص وحماة ودير الزور والرقة. تتواجد قبيلة الظفير بشكل رئيسي في منطقة الفرات شرق البلاد، وكذلك قبيلة الوالدة في الرقة ودير الزور والبادية. كما تتواجد قبيلة اللهيب في الرقة ودير الزور.
وتشمل الخريطة القبلية أيضاً قبيلة العبيد في دير الزور والحسكة، والمحاميد في منطقتي حوران ودرعا، وقبيلة الحريري التي تمتد من درعا إلى دمشق وحلب. ويتركز زعبي ومسلم في حوران وجنوب سوريا، بينما ينتشر بني صخر في السويداء ودرعا والبادية الجنوبية.
في المناطق الشمالية والشرقية، تتواجد قبيلة الكنانة في الرقة ودير الزور والحسكة. وتُعد قبيلة العفادلة من القبائل النشطة في الرقة والبادية الوسطى، كما تتواجد قبيلة الحديدين في الرقة ودير الزور.
تراجع النفوذ التقليدي وصعود المؤسسة العسكرية

يقول الدكتور حيان دخان: “إن هيكل القيادة التقليدية للقبائل السورية يشهد تراجعًا تدريجيًا منذ عقود. ويعود ذلك إلى تزايد انتشار التعليم، وتراجع الاعتماد على تربية الماشية، وتزايد التحضر”.
ويضيف: “إن المشيخة التي كانت تحتكر في السابق سلطة اتخاذ القرار داخل القبيلة، شهدت تراجعاً في نفوذها بسبب التغيرات الاجتماعية العميقة، وخاصة صعود الطبقات المتعلمة وتغير أنماط الحياة”.
لكن مع اندلاع الثورة السورية وتفكك سلطة الدولة المركزية، عادت الهويات المحلية والولاءات الفرعية إلى الواجهة، ما أعاد بعض شيوخ القبائل إلى الواجهة، وخاصة أولئك الذين اكتسبوا النفوذ من خلال امتلاكهم للأسلحة والأرض والأموال وشبكات العلاقات الداخلية والخارجية، بما في ذلك مع جهات إقليمية مؤثرة.
يوضح دخان أنه على الرغم من أن كاريزما الزعيم القبلي لا تزال تلعب دورًا حاسمًا في المجتمعات الريفية والمهمشة، إلا أنها لم تعد كافية بمفردها للحفاظ على السيطرة. ويشير إلى أنه “خلال سنوات الصراع، نشأ تنافس بين المشيخة الوراثية من جهة، والقادة الجدد الذين ظهروا داخل التشكيلات القبلية المسلحة من جهة أخرى”. وقد أدى هذا التنافس إلى ظهور أشكال هجينة من القيادة تجمع بين الشرعية التقليدية والسلطة العسكرية.

يشير دخان إلى أن التغييرات في القيادة القبلية “لم تكن مجرد انعكاس للفوضى”، بل كانت أيضًا نتيجة مباشرة لانهيار النموذج المركزي الذي فرضته الدولة لعقود. “مع انسحاب الدولة من مناطق شاسعة، ظهرت فجوات سرعان ما سُدّت. لذلك، كان من الطبيعي أن تعود القبيلة كفاعل مهم، لا سيما في المجتمعات التي كانت تُحكم سابقًا بمركزية أمنية بدلًا من الخدمات أو التمثيل”.
ويشير إلى أن شيوخ القبائل الذين حصلوا على موارد – سواء من خلال التجارة المحلية أو الدعم الخارجي أو العلاقات مع جهات إقليمية فاعلة – تمكنوا من ترسيخ مكانتهم كسلطات شبه سياسية. ويزعم: “نشهد تحولاً من القيادة الاجتماعية التقليدية إلى ما يشبه سلطة الأمر الواقع”، مؤكداً أن بعض شيوخ القبائل أصبحوا وسطاء بين السكان والقوات المسلحة المتنافسة، مما منحهم نفوذاً يتجاوز سياقهم القبلي المحض.
فيما يتعلق بالعلاقة بين القبائل والدولة، يرى دخان أن نظام الأسد السابق استغل القبائل سياسيًا بشكل واضح في العقود الأخيرة، سواءً من خلال الاستقطاب أو التهميش. “لكن بعد عام ٢٠١١، لم تعد الدولة الطرف الوحيد المعني بالقبائل. بل ساهمت جهات دولية وإقليمية أيضًا في دعم بعض الجماعات القبلية لكسب نفوذ محلي أو خلق بيئة اجتماعية حاضنة للقوات المسلحة التابعة لها.”
ويشير دخان إلى أن العديد من الصراعات داخل المجتمع القبلي السوري “لم تعد تقتصر على مسائل السلطة، بل أصبحت متشابكة مع خطوط الصراع السياسي والإقليمي والطائفي، مما يزيد الوضع تعقيداً ويضعف إمكانية العودة إلى نموذج موحد للقيادة التقليدية”.
لكل فتاة الحق في الطيران

في قلب مجتمع قبلي يتمسك بتقاليده وسط صراعات ناجمة عن الحرب والنزوح، تروي آيات الحمادي، وهي شابة من قرية الشعرة شرقي المعرة بمحافظة إدلب، قصة رحلة تعليمية طويلة وصعبة رغم كل العوائق الاجتماعية والسياسية.
كنتُ الابنة الثانية لوالديّ. نشأتُ في قريةٍ تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. لم يكن هناك مركزٌ صحي، ولا مواصلات، ولا أمنٌ للفتيات اللواتي يحلمن بالتعليم، هكذا قالت آيات لبي بي سي عربي. انتقلت عائلتها لاحقًا إلى سنجار، وهي قضاءٌ تسكنه عدة قبائل، لتوفير تعليمٍ أفضل لها.
لكن التغيير لم يُغيّر تصورات الفتيات؛ إذ ظلّ خوف العار والمجتمع يُطاردهن، كما تقول. “أُجبرت الفتيات على ترك المدرسة مُبكرًا للعمل في رعي الماشية أو الزواج، وكأن التعليم عارٌ لا يُغتفر”.
رفضت آيات، ومع اندلاع الحرب السورية، ازداد الوضع الأمني سوءًا، وزاد نفوذ العشائر، كما تقول. ومع ذلك، “كان هناك صراع داخلي شرس: هل عليّ أن أكون مثل الفتيات الأخريات، أم أن أثبت أن نساء القرية يستحققن النجاح أيضًا؟”
عندما تقدم لخطبتها، قالت آيات لنفسها: “كنت بحاجة إلى شخص يحميني ويشجعني على الاستمرار. الحياة في المخيم قاسية، لكنني قررت الاستمرار”.
ورغم هذه الظروف، تفتخر آيات ببعض جوانب ثقافتها: “تتميز عاداتنا القبلية بالفروسية والكرم، لكن كرامة الفتاة غالباً ما تُقاس بطاعتها، وليس بحجم أحلامها”.
تقول إنها تؤمن بأن “الفروسية العربية الأصيلة لا تقيد المرأة، بل تكرمها. لكل فتاة الحق في الطيران دون أن يُقص جناحاها قبل الإقلاع”.
ما هو حجم القوة العسكرية لرجال القبائل؟
بناءً على التقارير الموثوقة المتاحة، بالإضافة إلى البحوث الصحفية والأكاديمية، يمكن تقسيم التشكيلات العسكرية القبلية التي ظهرت ولا تزال تظهر خلال النزاع السوري إلى مجموعات لعبت أدوارًا مختلفة – بعضها إلى جانب النظام، وبعضها ضده. ونظرًا لتغير التحالفات والتوزيع الجغرافي، يصعب تقديم أرقام دقيقة عن عدد هذه التشكيلات. ومع ذلك، يمكن رسم صورة تقريبية لأهمها:
وفي شمال شرقي سوريا، أصبح لواء الباقر، الذي يتألف في معظمه من أفراد قبيلة البقارة، أحد أهم الفصائل الموالية للنظام.
نشأ هذا التشكيل في حلب ومحيطها، وارتبط لاحقًا بإيران عبر الدعم المالي واللوجستي. دُرب مقاتلوه على يد الحرس الثوري الإيراني. شارك اللواء في القتال في حلب ومحيطها شرق البلاد، ورسّخ وجوده كواجهة محلية ضمن مشروع النفوذ الإقليمي الإيراني. علاوة على ذلك، ووفقًا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فقد حمى المصالح الاقتصادية لبعض العائلات المرتبطة بالنظام.
وتشير بعض التقديرات السورية المحلية إلى أن عدد مقاتلي التنظيم في ذروة قوته بلغ نحو ألفي مقاتل.
في المقابل، ظهرت فصائل قبلية معارضة للنظام، مثل “جيش أحرار العشائر” الذي ضم مقاتلين من القبائل العربية في الجنوب الشرقي (مثل بني خالد والنعيم)، وكان ناشطاً في منطقتي البادية واللجاة في محافظة درعا.
وفقًا لمؤسسة جيمستاون، لعب هذا الفصيل أيضًا دورًا في العمليات ضد ما يُسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لكن أهميته تراجعت لاحقًا بسبب الضغط الروسي وسياسة المصالحة التي ترعاها موسكو في جنوب سوريا. ورغم قلة تسليحه وقوته العددية، اعتُبر مثالًا مبكرًا على تسليح الجماعات القبلية داخل المعارضة.

في محافظة دير الزور، نشأت تشكيلات قبلية مختلطة، منها مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفقًا لمعهد أبحاث الحرب. يضم المجلس مقاتلين من قبائل العكيدات والبكارة والجبور، وكان له دور في طرد داعش من شرق الفرات.
واجه المجلس لاحقًا تحدياتٍ نتيجةً لغياب تمثيلٍ حقيقيٍّ للقبائل. وتشير تقارير إعلامية سورية إلى أن ذلك أدى إلى احتجاجاتٍ محليةٍ وانتقاداتٍ من شيوخ القبائل، تصاعدت أحيانًا إلى اشتباكاتٍ مسلحةٍ في الجزء الشرقي من المحافظة.
في الرقة، وبدعم أمريكي، تشكلت مجموعات محلية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، ضمت أفرادًا من قبائل الولدة والسبخة والبوحمد. إلا أنها افتقرت إلى النفوذ المستقل، واندمجت وظيفيًا ضمن القيادة الكردية الشاملة لقوات سوريا الديمقراطية.
في إدلب ومحيطها، ورغم سيطرة المتشددين الإسلاميين كهيئة تحرير الشام، كانت العشائر ممثلة في المجالس المحلية ولجان المصالحة، لا سيما في منطقتي جبل الزاوية والغاب. إلا أن هذه العشائر لم تُشكل تكتلات عسكرية منظمة، بل كانت بمثابة حاضنة اجتماعية لفصائل المعارضة.
تُظهر هذه الأمثلة أن الجيوش القبلية السورية لم تكن متجانسة من حيث الولاء والهيكل التنظيمي. تطور بعضها إلى قوات شبه عسكرية، بينما اختفى بعضها الآخر نتيجة ضغوط سياسية أو عسكرية. ومع ذلك، ظلّ العامل القبلي عاملاً حاسماً في تجنيد المقاتلين، وفي بعض الأحيان في حل النزاعات المحلية أو السيطرة على موارد معينة كالنفط أو المعابر الحدودية.
“إن تغيير الولاء ليس خيانة.”
يوضح الدكتور حيان دخان، الباحث المتخصص في ديناميكيات القبائل في سوريا، أن انتقاد القبائل لـ”تغيير ولائها” للأطراف المتصارعة لا يعكس الحقيقة كاملة. ويجادل بأن هذه السلوكيات لا تنبع من “خيانة وطنية”، بل من تهديد وجودي خارجي.
يشير دخان إلى أنه عندما تواجه القبائل تهديدًا يُنظر إليه على أنه أكبر من أي انتماءات سياسية، فإنها تتحد وتدافع عن أرضها أو شعبها، حتى لو تطلب ذلك تعديلًا مؤقتًا في ولاءاتها. ويوضح دخان أن هذا النمط “لا يقتصر على المجتمعات القبلية، بل يمكن ملاحظته في جميع أنحاء العالم: في مواجهة التهديدات الكبرى، تتلاشى الانتماءات”.
لدعم هذه الحجة، يستشهد دخان بمثال العشائر الاسكتلندية (حروب العشائر)، التي خاضت صراعات داخلية شرسة مرارًا وتكرارًا عبر التاريخ. ومع ذلك، في مواجهة الغزو أو التهديد بالعدوان الخارجي، وحدت العشائر، رغم اختلافاتها العميقة، صفوفها تحت قيادة موحدة للدفاع عن الجزيرة. ويجادل دخان بأن هذا الموقف التاريخي يُظهر أن الولاء القبلي ديناميكي وقابل للتكيف، ويوجهه الأمن والمصالح الاجتماعية.
يختتم دخان قائلاً: “إن تغيير الولاء لا يعني توحيد جميع القبائل في رأي سياسي واحد، بل هو استجابة استراتيجية لتهديد وجودي يهدد بقاء المجتمع. إنه تحول مؤقت في سياق الواقعية السياسية، وليس تحولاً طوعياً أو قسرياً”.