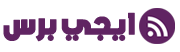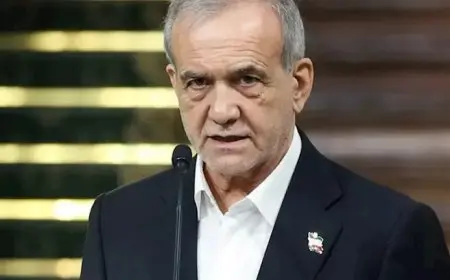بلاد الشام: هل كان لبنان حقًا جزءًا من سوريا؟

أثار مصطلح “بلاد الشام” جدلاً متجدداً عقب تصريحٍ صدر مؤخراً عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، حذّر فيه من أن لبنان “سيعود إلى بلاد الشام” إذا لم تُحلّ مسألة سلاح حزب الله سريعاً. وعزا ذلك إلى تغيير النظام الحاكم في سوريا.
ورغم أن باراك سارع في وقت لاحق إلى التأكيد على أن القادة الجدد في سوريا “يريدون فقط التعايش والازدهار المشترك مع لبنان”، فإن هذا لم يمنع من اندلاع عاصفة من السخط بسبب تصريحات المبعوث الأميركي ومصطلح “بلاد الشام”.
ماذا يعني مصطلح بلاد الشام؟ وما هو تاريخ الانقسام السياسي لهذه المنطقة؟
ساحة المعركة
بلاد الشام هو مصطلح جغرافي وتاريخي يستخدم لوصف المناطق الشاسعة التي تشمل الآن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، وشملت في بعض الأحيان أجزاء من جنوب تركيا وشمال المملكة العربية السعودية وشبه جزيرة سيناء في مصر.
لقد كانت هذه المنطقة في غرب آسيا تحت سيطرة العديد من الإمبراطوريات العظيمة عبر التاريخ، بما في ذلك مصر القديمة، وآشور، وبابل، وبلاد فارس، واليونان، والإمبراطورية الرومانية.
وبسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كانت هذه المنطقة الشاسعة مسرحاً لصراعات كبرى بين القوى والإمبراطوريات المتنافسة، مثل المواجهات بين المصريين القدماء في عهد تحتمس الثالث والشعوب الكنعانية في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، أو الحرب بين الإمبراطورية البيزنطية (الرومانية الشرقية) والإمبراطورية الساسانية (الفارسية) في القرن السابع الميلادي، وهي الحرب المذكورة في القرآن الكريم في سورة الروم.
وفي القرن السابع الميلادي، ومع انتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية، بدأت الحملات الإسلامية للغزو، فوسعوا سيطرتهم على مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا، ثم على أجزاء من أوروبا في وقت لاحق.
ومع انتشار الإسلام واللغة العربية، بدأ مصطلح “بلاد الشام” يترسخ في الأدب العربي.
هناك تفسيرات مختلفة لتسمية هذه المنطقة، منها ما يربطها باشتقاقات قديمة قد تكون مرتبطة بالسماء في بعض اللغات السامية. وهناك أيضًا صلة بينها وبين شخصية سام بن نوح المذكورة في التوراة. كما يُرجع البعض الاسم إلى وقوع هذه المنطقة على يسار (شمال) مكة المكرمة في اتجاه شروق الشمس، بينما تقع اليمن على يمينها.
وفي المصادر الغربية كانت تعرف بأسماء عديدة، منها “بلاد الشام” و”سوريا”، وهو اسم يظهر في الكتابات القديمة، مثل تاريخ المؤرخ اليوناني هيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد.
عاصمة الأمويين

وازدادت أهمية المنطقة بعد أن اتخذ الأمويون دمشق عاصمة لدولتهم التي استمرت نحو تسعين عاماً.
بعد سقوط الدولة الأموية وصعود العباسيين، انتقلت عاصمة الخلافة الإسلامية إلى بغداد، وتراجعت مكانة دمشق السياسية لصالح العاصمة الجديدة. إلا أن العصر العباسي الذي امتد لقرون شهد صعود حلب كمركز سياسي وثقافي رئيسي، منافسًا دمشق على النفوذ في بلاد الشام.
تشير كتب التاريخ الإسلامي إلى أن بلاد الشام في العصر العباسي لم تكن تُدار كوحدة سياسية موحدة تحت سلطة والٍ واحد، بل كانت مُقسّمة إلى عدة وحدات إدارية، مثل ولايتي دمشق وحمص، ولكلٍّ منهما والٍ مستقل.
مع تراجع نفوذ الخلافة العباسية، ظهرت إمارات وممالك محلية في بلاد الشام، بعضها يتمتع باستقلال شبه كامل، بينما كان بعضها الآخر تابعًا للخلافة اسميًا فقط. خضعت أجزاء من بلاد الشام لسيطرة الفاطميين، الذين تنافسوا مع العباسيين على الشرعية الدينية والسياسية.
وفي عهد الخلافة العباسية، فقد المسلمون أيضًا السيطرة على مناطق مختلفة في بلاد الشام، كما حدث بالفعل أثناء الحروب الصليبية التي استمرت ما يقرب من مائتي عام.
بعد أن غادر الصليبيون الشرق في عام 1291، انتقلت السيطرة على بلاد الشام إلى دولة المماليك في مصر، والتي استمرت في تقسيم المنطقة إلى عدة وحدات إدارية، عادة ستة، تسمى “نيابات” أو “ممالك”، بما في ذلك دمشق وحلب وحماة وطرابلس وصفد والكرك.
وكانت صيدا وبيروت تحت سلطة دمشق.

العثمانيون
شهد القرن السادس عشر صعود قوة جديدة. هزم العثمانيون المماليك، وأنشأوا إمبراطورية سيطرت على أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، بما في ذلك بلاد الشام، لقرون.
بحسب المؤرخ اللبناني شارل حايك في مقابلة مع بي بي سي العربية، قُسِّمت منطقة بلاد الشام إلى عدة وحدات سياسية خلال العهد العثماني، تفاوتت في شكلها وتخطيطها بشكل كبير. إلا أنه ولفترة طويلة، كانت هناك أربع وحدات إدارية رئيسية (إيالات): إيالة حلب، إيالة دمشق، إيالة طرابلس، وإيالة صيدا.
تتألف كل مقاطعة من وحدات إدارية أصغر تسمى “السنجق”.
على سبيل المثال، ظلت بيروت خلال العهد العثماني سنجقاً تابعاً لمحافظة صيدا لفترة طويلة.
ومع مرور الوقت، بدأ نفوذ الدولة العثمانية في التراجع، وفسحت المجال لاتجاهات متزايدة نحو الاستقلال، كما حدث في عهد الوالي المصري محمد علي (1805-1848)، عندما سيطرت قواته على بلاد الشام خلال ما يسمى بالنهضة المصرية (1831-1841).
ثم جاءت الأحداث الكبرى في القرن التاسع عشر، والتي ألقت بظلالها على التقسيم الإداري لهذه المنطقة.
ابتداءً من عام ١٨٥٠، اندلعت أعمال عنف طائفي دموية في حلب، تلتها بعد عشر سنوات أعمال عنف في جبل لبنان ودمشق. قُتل العديد من المسيحيين، واشتعلت موجة من الغضب في جميع أنحاء أوروبا.
إثر هذه الأحداث الدامية، وتحت ضغط أوروبي، قررت السلطات العثمانية تغيير النظام الإداري للأراضي الشامية. فأنشأت أولًا وحدة إدارية، هي المتصرفية، في جبل لبنان، التي تمتعت بقدر من الاستقلال الذاتي، وحكمها زعيم مسيحي ليس من أصل جبلي.
وفي عام 1864 تأسست الدولة السورية، التي ضمت الوحدات الإدارية دمشق وطرابلس وصيدا.
ويقول تشارلز هايك إن تسمية المحافظة الجديدة “سوريا” تعكس وعياً تاريخياً لدى النخب المحلية التي اقترحت الاسم.
وبحسب كتاب “مذبحة دمشق: مذبحة 1860 وتكوين الشرق الأوسط الجديد” للمؤرخ البريطاني يوجين روغان، فقد تنافست دمشق وبيروت على شرف أن تصبح عاصمة الولاية السورية التي تأسست حديثاً قبل أن يستقر العثمانيون في دمشق.
غيّر العثمانيون لاحقًا التقسيم الإداري للإمبراطورية العثمانية الشرقية، وأعلنوا تأسيس متصرفية القدس. ثم أسسوا وحدة إدارية جديدة، هي ولاية بيروت، التي ضمت الأراضي التي كانت سابقًا جزءًا من ولايتي صيدا وطرابلس.

الحرب العالمية الأولى وتأسيس لبنان وسوريا
وكما كان للقرن التاسع عشر تأثير كبير على بلاد الشام العثمانية، فإن القرن العشرين بدوره جلب معه العديد من رياح التغيير.
دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولى (1914-1918) إلى جانب ألمانيا وإمبراطورية هابسبورغ (التي ضمت بشكل رئيسي النمسا والمجر)، وقاتلت ضد بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا، ولاحقًا الولايات المتحدة. واندلع قتال عنيف في الشرق الأوسط.
ومن أهم الأحداث الثورة ضد العثمانيين بقيادة حاكم مكة الشريف حسين وبدعم من بريطانيا العظمى.
ومع نهاية الحرب واستيلاء بريطانيا العظمى وفرنسا على الأراضي العثمانية، بدا الشرق الأوسط على وشك حدوث تغييرات كبرى، خاصة في ضوء الوعود المتناقضة التي قطعتها القوى المنتصرة، وخاصة بريطانيا العظمى، خلال الحرب.
تعهدت بريطانيا العظمى بدعم الشريف حسين في تأسيس دولة عربية مستقلة. علاوة على ذلك، أبرمت اتفاقية سرية (اتفاقية سايكس بيكو) مع فرنسا وروسيا القيصرية لتقسيم مناطق النفوذ في الشرق العثماني. كما وقّعت وعد بلفور الذي أنشأ وطنًا قوميًا لليهود في فلسطين.
وفي أعقاب هذه الأحداث المتلاحقة، ظهرت حركات سياسية في منطقة المشرق العربي، تحمل مواقف متباينة بشأن مستقبل المنطقة.
كان لدى أنصار الاستقلال آمالٌ وتطلعاتٌ عريضةٌ لمبدأ تقرير المصير الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون. وتتجلى قوة هذه الآمال في أن أحد أبرز ممثلي السلفية المعاصرة، الشيخ محمد رشيد رضا، المولود في القلمون قرب طرابلس، أشاد بويلسون إشادةً كبيرةً في مقالٍ نُشر في كتاب المؤرخة إليزابيث طومسون “كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب”.
في المقابل، ارتفعت أصوات في جبل لبنان، وبخاصة في الأوساط المارونية، تطالب بإنشاء كيان مستقل عن بقية أقاليم المشرق بدعم فرنسي.
في عام 1920، تم إعلان قيام المملكة السورية، والتي تتكون من أجزاء من محافظتي دمشق وحلب وتحت حكم الأمير فيصل (الذي أصبح فيما بعد الملك فيصل).
إلا أن المملكة السورية الناشئة لم تدم سوى بضعة أشهر، إذ خالفت الاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها في مؤتمر سان ريمو، والتي نُفذت لاحقًا بالقوة العسكرية. ووُضعت الأراضي الحالية في سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، بينما وُضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

في عام ١٩٢٠، أعلنت فرنسا إنشاء لبنان الكبير، الذي ضمّ جبل لبنان وعدة مناطق، منها بيروت وطرابلس وصيدا. هذا هو لبنان كما نعرفه اليوم.
وفي سوريا تم تقسيم المنطقة إلى عدة ولايات: ولاية دمشق، ولاية حلب، ولاية الساحل، ولاية جبل العرب.
وفي عشرينيات القرن العشرين اندلعت ثورة ضد الانتداب الفرنسي في الأراضي السورية، قبل أن يتم إعلان الدولة السورية الموحدة في عام 1930.
بعد استقلال لبنان وسوريا عن فرنسا في أربعينيات القرن الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين تطورات هامة، مما أدى إلى تشابك وثيق في مصيريهما. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية وما بعدها، مارست سوريا نفوذًا سياسيًا وعسكريًا كبيرًا في لبنان.
وفي عام 2005، انسحب الجيش السوري من لبنان في أعقاب الضغوط الدولية المتزايدة على دمشق، وخاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
كما شارك حزب الله اللبناني إلى جانب قوات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الصراع ضد المعارضة المسلحة، والذي انتهى بالإطاحة بحكم الأسد في عام 2024.
ولكن هل يمكن لهذا التاريخ الغني والمتشابك للمنطقة أن يبرر الحديث عن العودة السياسية إلى بلاد الشام؟
يقول المؤرخ اللبناني شارل حايك إن أصحاب هذا الرأي يعتمدون على “تفسيرات خيالية دون الرجوع إلى التاريخ”. ويرى أن المغالطة تكمن في اعتبار بلاد الشام مصطلحًا لكيان سياسي، وهو أمر غير صحيح. لم تتطور لبنان وسوريا إلى دولتين بالمعنى الحديث إلا بعد الحرب العالمية الأولى.
ويختتم الحايك كلمته بالتحذير: “لا يمكن بناء المستقبل على الماضي. الماضي موجود لنتعلم منه”.