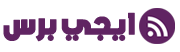هوليوود تعود بفيلم «Warfare» الأكثر واقعية عن حرب العراق

بعد فترة من التراجع شهدت تراجع أفلام الحرب الجريئة التي أنتجتها هوليوود مثل “إنقاذ الجندي رايان” عن الحرب العالمية الثانية، و”سقوط الصقر الأسود” الذي صوّر الهزيمة الوحشية التي لحقت بالقوات المسلحة الأميركية في الصومال، أو أفلام “13 ساعة” و”الناجي الوحيد”، عادت عاصمة السينما الأميركية الآن بما يقول النقاد إنه أجرأ فيلم حرب وأكثرها إثارة للرعب: “حرب”.
تدور أحداث الفيلم حول مهمة عسكرية أمريكية فاشلة في العراق خلال حرب العراق عام 2006، ويصور وحشية الحرب بأسلوب واقعي يشبه الأفلام الوثائقية. وهذا ما يجعله أحد أفضل أفلام هذا العام لأنه، كما يقول النقاد الغربيون، “خالي من أي اصطناعية”.
يقدم الفيلم تجربة مغامرة بتصميم صوتي ممتاز ويقرب عنف الحرب إلى المشاهد دون تمجيده بل من خلال تصويره بصدق. وفي تقارير من الصحف والمجلات الأمريكية مثل نيويوركر، والغارديان، وبيزنس ديلي، وصف النقاد الفيلم بأنه فيلم الحرب الأكثر واقعية على الإطلاق ووصفوه بأنه كلاسيكي احترافي يعكس حقيقة الصراع بشكل مقنع.
تدور أحداث الفيلم حول فريق من قوات البحرية الأمريكية الخاصة خلال حرب العراق، والذين يبحثون عن ملجأ في منزل عائلة عراقية بعد أن حاصرتهم القوات العراقية ويقاتلون من أجل البقاء.
لا يروي الفيلم قصة حقيقية فحسب، بل يقدمها بشكل بصري وتجريبي يرفض كل الأعراف ويعمل بمثابة صرخة فنية ضد الصور النمطية وعناصر هوليوود التي لطالما مجدت الحرب في السينما الأمريكية وصورت الأمريكيين كأبطال خياليين.
في أحدث مشاريعه السينمائية، يقدم المخرج البريطاني أليكس جارلاند فيلم “Warfare” بالتعاون مع راي ميندوزا، وهو جندي سابق في قوات النخبة في البحرية الأميركية.
لإعداد السيناريو، أجرى الثنائي (جارلاند وميندوزا) مقابلات مع عدد من جنود مشاة البحرية السابقين وأفراد قوات البحرية الخاصة الذين شاركوا في الحرب.
يعلن عنوان الفيلم في البداية: “يستخدم هذا الفيلم ذكرياتهم المؤلمة، وهذه إشارة إلى البداية. إنه فيلم حرب معروف بما لا يقدمه”.
الفيلم مأخوذ عن عملية حقيقية جرت في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار العراقية، حيث قامت وحدة من القوات الخاصة الأميركية بمهمة مراقبة مكثفة في شقة صغيرة لعدة أيام.
في عام 2006، وقعت معركة شرسة في مدينة الرمادي بالعراق، استمرت من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني، وأصبحت تُعرف باسم “معركة الرمادي الثانية”. وكان هدف المعركة هو السيطرة على المدينة.
ولكن ما يميز فيلم “حرب” عن غيره من الأفلام هو القرار بعدم التركيز على البطولات الفردية أو العرض العسكري، بل على تفاصيل “العملية” ككل جماعي، دون أسماء أو أبطال.
منذ المشهد الأول، يواجهنا الفيلم بشكل مباشر بتناقضات الحرب. يبدأ الأمر بمشهد من الفيديو الموسيقي الشهير لأغنية “Call on Me” في صالة ألعاب رياضية للسيدات، والذي تشاهده المجندات الشابات بدهشة.
في لقطة واحدة، يجمع الفيلم بين الجسد والرغبة والتحرر العاطفي قبل أن ينقلنا فجأة إلى ظلام العراق، حيث لا توجد مشاهد بطولية، بل صمت وترقب وخوف متزايد.
يشارك في بطولة الفيلم ويلي بولتر (الوحيد الذي حصل على دور بارز)، بالإضافة إلى نوح سنتينيو، وتشارلز ميلتون، وجوزيف كوين، وكيت كونور، لكن أداءهم يتحول إلى مجموعة لا تترك مجالًا للفردية.
الصور هنا خالية من المبالغة. وفي مسعى للاقتراب من الحقيقة، حتى الصور النهائية للأشخاص الحقيقيين – التي تظهر عادة في نهاية الأفلام السيرية – تبدو غير واضحة، بما يتماشى مع فلسفة الفيلم في رفض “تمجيد الفرد”.
يلعب عمل الكاميرا، الذي أخرجه ديفيد جيه تومسون، دورًا حاسمًا في خلق شعور بالاختناق والانفصال عن العالم الخارجي.
الكاميرا لا تغادر الحي أبدًا، وتبقى محاصرة داخل الجدران، وتنقل “عزلة” الجنود، الذين لا يرون شيئًا من “العدو” سوى الظلال والأصوات.
ما يميز فيلم “حرب” أكثر من أي شيء آخر هو الجمع بين الخبرة العسكرية لميندوزا والوعي السينمائي لغارلاند، الذي يرفض القومية ويسعى إلى الصدق البصري والنفسي.
ويستند الفيلم بشكل حصري على “ذكريات الجنود” الذين عاشوا هذه اللحظة، ويتخلص من الفواصل الدرامية والحوارات المصممة أو محاولات تصوير الجندي الأمريكي كشخصية “رامبو”، بل كإنسان عادي يقاتل ويعاني.
“الحرب” ليس فيلماً سيرة ذاتية ولا يركز على تجسيد الشخصيات. يتركز الاهتمام أكثر على الحرب التي وقعت من التركيز على الشخصيات. ولم يقتصر الأمر على انخفاض الأداء فحسب؛ بل لقد تم سلب فرديتهم عمليًا.
بمعنى آخر، “الحرب” هو عمل واقعي للغاية، وهو تمرين في كيفية التخلص من الخوف ببطء في الأماكن المغلقة، على الرغم من أنه يظهر جنودًا يفتقرون إلى أي فكرة واضحة عن من هم أعدائهم أو مكانهم.
وينتهي فيلم “الحرب” مثل العديد من الأفلام المقتبسة من أحداث حقيقية: بسلسلة من الصور والشخصيات التي يراها الجمهور. جميعهم من نخبة مشاة البحرية الأمريكية، وقد تم حجب وجوههم في هذه الصور لأسباب أمنية أو تتعلق بالخصوصية.
يحاول الفيلم أن ينقل “رسالة” مفادها أن كل فيلم حرب يعرف أن الحرب هي الجحيم، لكن عددا قليلا جدا يفهمون أن الجحيم لا يزال يحتوي على قواعد وأنظمة. ولذلك، وكما أشارت مجلة النيويوركر، يبدو الأمر كما لو أن الفيلم يخوض حربه الخاصة ضد الاتجاهات الجذابة والأعراف الكلاسيكية سهلة الهضم في هذا النوع من الأفلام.
ويبدو أن الفيلم “يتعارض مع توجه هوليوود ويتجاهل الأحداث أو يبسطها أو يعيد سردها”، بحسب صحيفة الغارديان.
لا توجد معارك ضارية تنتهي في دقائق معدودة، ولا توجد رحلات طويلة تنتهي بنهاية سارة كما في الأفلام الأخرى. تدور معظم أحداث الفيلم في زمن واقعي، ويقوم المخرجون الذين يكرهون المشاهد المتسرعة بإبطاء الأحداث ببراعة تقنية لجعل الفيلم أكثر واقعية.
على سبيل المثال، في منتصف الفيلم، ينفجر جهاز متفجر أمام مبنى سكني مباشرة، ولكن في التسلسل التالي، نرى الناجين يستعيدون وعيهم تدريجيًا، وأجسادهم مغطاة بالغبار والدخان، ويكافحون من أجل النهوض.
يبدو أن الجنديين إليوت وسام قد تم تعطيل مستقبلات الألم لديهما. إنهم لا يدركون على الفور أنهم أصيبوا بإصابات بالغة أدت إلى شللهم، وأن أجزاء الجسم متناثرة من حولهم، وأنهم يواجهون موتًا بطيئًا. حتى بعد حقنة المورفين وبعض الضمادات، لم يتوقف الرجلان عن الصراخ.
ومع ذلك، يحاول فيلم “الحرب” التركيز على التاريخ الموثق، وليس على مستقبل خيالي. وهكذا، بعد مشاهدة فيلم «الحرب»، لا يزال المشاهد يسمع صراخ الجنود، ويرى حقيقة الوجود العسكري الأميركي في العراق، والذي وصفه النقاد بأنه «ليس أكثر من تدخل عنيف ومضلل».
تجاهل الخسائر العراقية
ورغم أن الفيلم تدور أحداثه في منزل عائلة عراقية اختاره الجنود لأن أحدهم أعجبه، وتستغرق أحداثه 90 دقيقة في المنزل العراقي وبين العائلة العراقية، إلا أنه يفشل في التقاط مشاعر العراقيين والجنود الأميركيين.
وتقول صحيفة الغارديان: “إن حقيقة أن فيلماً حربياً لا يظهر الجانب الآخر، وأن الأسرة العراقية والكشافة أكثر غموضاً بالنسبة لنا من الجنود، تبدو غير عادلة وصادقة في آن واحد”.
وهذا اعتراف بنقص واسع النطاق ومروع في الخيال والآثار المدمرة للعقل والروح القتالية على المستوى الشخصي.
في نهاية الفيلم، وبعد أخذ الجنود الأميركيين القتلى والجرحى، يتم تصوير العراقيين الذين يقاتلون الغزاة على أنهم “متمردون”. ويظهر الفيلم أيضًا عائلة عراقية وهي تنظر إلى بقايا منزلها المدمر.