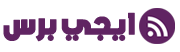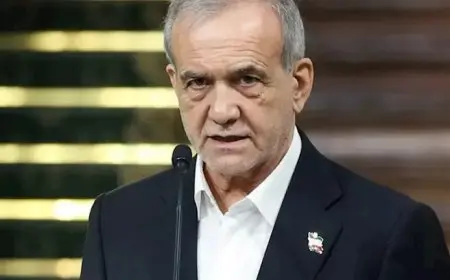تحدّى المؤسسة الدينيّة وانتقد “خروج الثورة من المساجد”، ماذا نعرف عن الشاعر السوري أدونيس؟

هناك عدد قليل من المثقفين العرب الأحياء القادرين على إثارة نقاش حاد كلما ذكر اسمهم. من المؤكد أن أدونيس هو واحد من هؤلاء القلائل، إن لم يكن الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق.
لا يعتبره الكثيرون أحد أهم الشعراء العرب المعاصرين فحسب، بل ظل أيضًا شخصية محورية في الفكر العربي المعاصر منذ ستينيات القرن العشرين، حيث اجتذب باستمرار الإعجاب الكبير والنقد الحاد.
على مدى العقد الماضي، ارتبط اسم أدونيس على نطاق واسع بجائزة نوبل، حيث تم ترشيحه لها بانتظام منذ عام 1988 دون الفوز بها. وبعد أن أصبح أول كاتب عربي يفوز بجائزة جوته الألمانية في عام 2011، أصبح اسمه مرشحاً بشكل متزايد للحصول على جائزة نوبل. وقد وصل الأمر إلى حد أن أصبح ميمًا يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في نفس الوقت تقريبًا من كل عام عندما يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة الدولية.
على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، اشتدت الاستقطابات حول موقف أدونيس بسبب تعليقاته على الثورة السورية منذ انطلاقتها، وخاصة بعد أن وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد نشرتها صحيفة السفير اللبنانية في يونيو/حزيران 2011، واصفاً إياه بالرئيس الشرعي المنتخب.
وكان قد أطلق في وقت سابق تصريحه الشهير بأن الثورة “لا يمكن أن تأتي من المسجد”.
ومؤخراً، وجد أدونيس نفسه مجدداً في قلب الجدل بعد مشاركته في مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس وإدانته للمجازر على الساحل السوري. أدونيس من الساحل وينتمي إلى الطائفة العلوية.
وبعد سقوط النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن أيضاً أنه “من الضروري تغيير ليس النظام فحسب، بل المجتمع أيضاً”.
وقد أثارت هذه الآراء وغيرها الكثير من الناس الذين لم يتمكنوا من التفاهم مع الشاعر واتهموه بالإسلاموفوبيا والطائفية.
ولكن موقف أدونيس في قلب المناقشات في العالم العربي ليس بالأمر الجديد. بل هو قديم قدم مسيرته الفكرية التي اتسمت منذ البداية بفكرة الحداثة وتحدي التقاليد. بالنسبة للبعض، أصبح “مدمرًا للمقدسات”، ويستحق الثناء على شجاعته في انتقاد الثقافة الإسلامية على وجه الخصوص، بينما بالنسبة للآخرين، فقد تبنى وجهة نظر اختزالية للشرق والإسلام.
الهوس بـ “الحداثة”

ولد علي أحمد سعيد إسبر عام 1930 في قرية قصابين في محافظة اللاذقية، وأعاد اختراع نفسه مبكراً (1947) باعتماد اسم أدونيس الذي يرمز إلى التجديد والبعث الأسطوري. وسيظل وفيا لمعنى الاسم الذي استعاره من إله الخصوبة والموت والقيامة في الأساطير الشرقية ما قبل الإسلامية.
بعد فترة قصيرة من السجن في سوريا بسبب عضويته في الحزب القومي الاجتماعي السوري، سافر أدونيس إلى العاصمة اللبنانية بيروت في عام 1956، حيث قال إنه شهد “ولادته الثقافية”.
كانت ولادته الكونية في باريس عام 1960، قبل أن يصدر بعد عام كتاب “أغاني مهيار الدمشقي”، الذي يمثل نقطة تحول في تطور الشعر العربي الحديث. ويعتبر أيضًا عملًا أساسيًا لما يسمى الآن بـ “القصيدة الحديثة” في الشعر العربي.
تزوج أدونيس من خالدة سعيد، الناقدة الأدبية السورية الشهيرة.
من أشهر أعماله الأدبية رواية “الكتاب” التي صدرت في ثلاثة أجزاء بين عامي 1995 و2002، ورواية “هذا اسمي” (1971).
لقد كانت مسيرة أدونيس الفكرية موجهة نحو مهمة واضحة: خلق حداثة عربية خالية من قيود التقاليد الثابتة. في قصائده وكتاباته الرائدة، أكد أدونيس مراراً وتكراراً أن ركود العالم العربي كان بسبب تراثه الفكري والديني، والذي اعتبره “مقاوماً للتغيير بطبيعته”.
وفي أعماله المهمة مثل “مقدمة في الشعر العربي” و”الثابت والمتغير” (1974)، طرح أدونيس أطروحته التي تدور حول “ضرورة القطيعة المعرفية مع الماضي من أجل تحقيق التحديث الحقيقي”.
وعلى النقيض من المفكرين الآخرين الذين سعوا إلى الإصلاح داخل الإسلام، زعم أدونيس أن بنية الحضارة الإسلامية ـ نظرية المعرفة (نظام المعرفة) واللاهوت السياسي ـ “غير متوافقة مع الحداثة”.
ومنذ ستينيات القرن العشرين، ظل أدونيس وفياً لنقده للمؤسسة الدينية في العالم العربي، على الرغم من أن آراءه تغيرت جزئياً بسبب الأحداث السياسية في بيئته.

“إن تسييس الدين يشبه تحويل الشمس إلى فرن.”
ومن الجدير بالذكر أن أدونيس يحرص دائماً على التمييز بين أمرين: الإسلام كعقيدة (أي الإسلام كدين في جوهره الروحي والنصي) وعلم اللاهوت الإنساني الإسلامي (أي كل التفسيرات والتوضيحات والفقه وعلم اللاهوت والفلسفة التي أنتجها البشر لاحقاً، أي العلماء والفقهاء والمعلقون عبر التاريخ).
ويركز انتقاده على النقطة الثانية.
في مقابلة نُشرت مؤخرًا في فبراير 2025، قال أدونيس: “الإسلام العربي، على الأقل، لا مستقبل له، لا على مستوى الحضارة ولا على مستوى الإبداع الثقافي. بل سيبقى قائمًا في ظل أنظمة فاسدة، ومؤسسات أشد فسادًا، وممارسات تُهين العقل البشري والفكر والحياة. وهكذا، سيبقى مثالًا يُحتذى به ومُضحكًا للعالم أجمع. هذا ما يريده التحالف الأمريكي الأوروبي: أن يبقى المسلمون العرب منغمسين في انشغالاتهم الخاصة، معزولين تمامًا عن الإنسانية والحاضر الإنساني المبدع. أن يبقوا منغمسين في وقاحة الاستهلاك وفي صراعاتهم الطائفية والقبلية”.
قبل نحو خمسين عاماً من هذه التصريحات، وتحديداً في عام 1973، وهو العام الذي نشر فيه كتابه الأشهر “الثابت والتغير”، عمل أدونيس على تطوير رؤية نقدية للثقافة العربية ترتكز على مفهوم الصراع بين قوتين رئيسيتين:
“الثابت” يشير إلى كل ما هو جامد وتقليدي ومرتبط برؤية عالمية مغلقة، بما في ذلك التفسيرات الدينية الصارمة والأطر الفكرية الجامدة التي تعيق أي تحول. ويجسد فيلم «المتحول» الديناميكية والإبداع والانفتاح على الحداثة، وخاصة في مجالات الفكر والأدب والفن.
ويرى أدونيس أن سيطرة “الثابت” على حساب “المتغير” تشكل عائقاً أمام التطور الفكري والإبداعي للثقافة العربية، وقد أدت إلى انغلاقها على الحداثة.
نُشر هذا الكتاب في أربعة أجزاء، وحظي بالإشادة لشجاعته، لكنه واجه أيضًا انتقادات، وخاصة من المفكرين المحافظين.
في مقابلة حديثة مع المجلة الثقافية اللبنانية “البعد الخامس”، كرّر أدونيس انتقاده للإسلام السياسي، قائلاً: “إن تسييس الدين أشبه بتحويل الشمس إلى فرن. إنه ليس تشويهاً للدين فحسب، بل للإنسانية وللإله نفسه”.
وهو مقتنع بأن “الثورة الإسلامية تُمثل، حتى يومنا هذا، ابتعادًا كاملاً عن عالم الفقه. لقد حوّل الفقه الدين إلى مجرد مجموعة من الأوامر والنواهي، مُطمسًا بذلك الفضاءات الروحية والإبداعية السامية التي سعى الصوفيون إلى إقامتها”.
وأكد مجددا الدعوة إلى “سلطة إسلامية حرة تستمد حريتها ليس من الفقه، بل من الوحي نفسه: من الكتاب الإلهي”.
بيان 5 يونيو

لقد اعتبر النقاد لفترة طويلة أن نقد أدونيس للواقع العربي والإسلامي “ثقافي”، لأنه يركز في المقام الأول على العوامل الثقافية والتقليدية باعتبارها الأسباب الرئيسية للتخلف والانحطاط، متجاهلاً إلى حد كبير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعب دوراً حاسماً في تشكيل هذا الواقع.
يقول مثلاً: “إن الإسلام، كدين وثقافة، يجد نفسه في مأزق تاريخي لم يكن معروفاً حتى في ظلام الخلافة العثمانية. ولا سبيل للخروج من هذا المأزق، الخالي من أي بُعد روحي أو إبداعي، إلا من خلال قراءة جديدة غير فقهية تتعمق وتتسع آفاقها في ضوء التجربة التاريخية، وخاصةً في ضوء مفهوم النسخ والمنسوخ الذي أرساه الوحي نفسه في تجاوز كلي للكتب الفقهية التي أصبحت جزءاً من الماضي وتجاوزتها التجربة التاريخية الحية”.
ويضيف: “بدون هذا سيبقى المسلمون مجرد أداة، مجرد سلطة، مجرد مجموعة بشرية تعيش على هامش الخلق الكوني”.
وتشير هذه الرؤية إلى مواقف سابقة له اتخذت مساراً مماثلاً.
وفي أعقاب هزيمة الجيوش العربية في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، أصدر أدونيس “إعلان الخامس من يونيو”، الذي ادعى فيه أن “العدو الذي هزمنا ليس عدواً خارجياً، بل عدواً داخلياً”، ودعا إلى “مواجهة الهزيمة من خلال ثورة فكرية وثقافية شاملة تنظر إلى الشعب العربي نفسه نظرة جديدة”.
ويرى المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي في كتابه “عصر اليسار الجديد” (2023) أن أدونيس “سيواصل نشر هذا الأسلوب (النقد الثقافي) بأشكال مختلفة، أغلبها معادية للحركات الشعبية، بحجة أن الثورة لا ينبغي أن تقتصر على السياسة بل يجب أن تكون ثورة ثقافية”.
“استيقظت شيعة أدونيس”

ولعل من أشهر المناظرات في تاريخ الفكر العربي المناظرة بين المفكر الماركسي السوري الراحل صادق جلال العظم وأدونيس في ثمانينيات القرن العشرين. وقد جرى هذا النقاش على خلفية حدثين: حدث سياسي ـ إطاحة الشاه بالثورة الإيرانية عام 1979 ـ وحدث ثقافي، تمثل في صدور كتاب “الاستشراق” للمفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد. وفي هذا الكتاب انتقد الصور النمطية المترسخة عن الشرق والإسلام والتي رسّخها المفكرون الغربيون عبر التاريخ.
أعرب أدونيس عن إعجابه بالثورة الإسلامية في إيران وكتب قصائد في مدحها.
وفي كتابه “عقلية التحريم” (1992)، رأى العظم، متأثراً بإعجابه بهذه الثورة، في أدونيس نموذجاً لـ”الاستشراق العكسي”.
ويرى العظم أن المفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد، في كتابه الشهير «الاستشراق» (1978)، وقع في الخطأ نفسه الذي انتقده في نظرية الاستشراق، إذ «تبنى رؤية المستشرقين نفسها، ولكن بشكل معكوس».
وكما أن “الاستشراق الأكاديمي الغربي يقوم على ميتافيزيقا الاختلافات الجوهرية الثابتة بين الشرق والغرب”، حسب العظم، فإن بعض المفكرين العرب يعيدون إنتاج هذه الميتافيزيقا بشكل معكوس، فيجعلون الإسلام المحرك الأساسي للتاريخ العربي، متجاهلين العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى العظم أن أدونيس تطور من الدعوة إلى القطيعة الكاملة مع التراث الديني في ستينيات القرن الماضي إلى الدفاع عن الأيديولوجية الإسلامية باعتبارها المحرك للتاريخ.
وفي كتاباته في هذه الفترة، رفض أدونيس مفاهيم القومية والعلمانية والاشتراكية باعتبارها غريبة عن “الكل الإسلامي”، في حين أكد على “التفوق الروحي للشرق على الغرب المادي”.
في ذلك الوقت، كان أدونيس، حسب العظم، يمثل رؤية للحداثة ترتكز على الإبداع كجوهر ميتافيزيقي خارج التاريخ والوجود. وفي رؤيته للإبداع، يمنحه أدونيس “صفات تجعله مفهوماً إلهياً تقريباً، لأنه يتماهى مع تجربة صوفية شرقية تتجاوز حدود التكنولوجيا والعقلانية الغربية”، كما يقول في كتابه “عقلية المحظور”.
ويرى العظم أن أدونيس يعيد إنتاج الاستشراق الغربي، ولكن من منظور شرقي معكوس، مما يعزز الانقسام بين الشرق والغرب بدلاً من حله.
في مقابلة أجريت معه عام 2013 مع مجلة العظم، كرر العظم تصريحًا أدلى به في أعقاب الثورة الإسلامية: “لقد استيقظت شيعية أدونيس”، مبررًا تصريحه بالقول إن أدونيس كتب قصيدة تمجد المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني.
ويضيف أن أدونيس “دافع عن ولاية الفقيه لا عن الثورة، ونظّر بلغة النبوة والإمامة والفقه الشيعي، وكتب أيضًا أن الإمامة استمرار للوحي النبوي”.
الموقف من الثورة السورية

ورغم أن موقف أدونيس تجاه الإسلام والثقافة العربية كان مثيراً للجدل منذ فترة طويلة، فإن موقفه تجاه الثورة السورية هو الأكثر إشكالية على المستوى الشعبي.
وعندما اجتاحت الاحتجاجات العالم العربي في عام 2011، رفض أدونيس تقديم الدعم الكامل للثورة السورية. وأكد على ضرورة العلمانية وحذر من الثورات التي تقودها القوى الإسلامية.
في عام ٢٠١٣، علّق صادق جلال العظم على تصريح أدونيس الشهير “الثورة لن تفارق المساجد”: “لكن من بنى مساجد في سوريا أكثر من أي عصر آخر؟ إنه عصر البعث. يريد أدونيس أن تُغادر دور السينما والمسارح. لكن من أغلق دور السينما في دمشق؟ إنه عصر البعث. إذا أراد أن تُغادر المؤسسات الثقافية التقدمية، فمن الواضح أنه لن يبقى للناس مكان يجتمعون فيه سوى المساجد”.
في مقابلة أجريت معه عام 2019، وصف أدونيس الربيع العربي بأنه “فشل” بعد أن كان متفائلاً في البداية.
وأضاف أدونيس أن “الثورة لا يمكن أن تكون حقيقية إلا إذا قدمت رؤية تحويلية تؤدي إلى مجتمع أفضل”.
وبدلاً من ذلك، يزعم أن الانتفاضات “أنتجت نتائج أسوأ من الأنظمة التي سعت إلى استبدالها”.
وانتقد حركات المعارضة لأنها “تعكس” الطغيان الذي سعت إلى الإطاحة به وأعرب عن أسفه لأن التغييرات السياسية لم يصاحبها تغيير ثقافي وأيديولوجي أوسع.
وانتقد أيضاً عجز حركات المعارضة العربية عن تحدي العقائد الدينية، وخاصة “فشلها في المطالبة بفصل الدين عن الدولة وتحرير المرأة من القيود الدينية”.
وفي المقابلة المذكورة قال أدونيس: “إن تغيير السلطة أو تغيير النظام السياسي وحده لا معنى له إذا لم يكن مرتبطا بمشروع تحسين المجتمع بمزيد من الحرية وتعميق البناء الاجتماعي المبني على القيم الإنسانية المشتركة، المنفصلة تماما عن الدين”.
وأضاف: “سوريا سئمت من كونها ظلاً في صحراء الأسد وعائلته، والآن سئمت أيضاً من كونها ظلاً في صحراء الخلافة العثمانية بعباءتها الأردوغانية”.
بعد ظهوره مؤخرا في مظاهرة في باريس، حيث أدان المجازر على الساحل السوري، عادت إلى الواجهة اتهامات قديمة بالطائفية ضد أدونيس.
في مقابلة تلفزيونية عام 2019، قال أدونيس إن صورة العلويين “مشوهة وصورة سياسية مفروضة عليهم. كطبقة أو كجماعة إسلامية، لا ينبغي لنا أن ننظر إليهم من خلال هذه الصورة السائدة”.
العلويون مثل سائر الشعوب؛ ومنهم الصالح والطالح. لكن ما أثار اهتمامي هو العمق الفكري الذي استندت إليه هذه الأفكار. والعمق الفكري، الممزوج بالعمق الروحي، هو نظرتهم للوجود. وكانت نظرتهم للوجود ترتكز على مفهوم من الفلسفة اليونانية، ثم أعطوه بعد ذلك بعداً إسلامياً: وهو يتعلق بالعلاقة بين المعنى والشكل. “إن لهذا الوجود معنى، ولكن هذا المعنى يتجلى في أشكال مختلفة.”
وفي المقابلة نفسها، أكد أيضًا: “الديمقراطية لا تعني مجرد القدرة على التصويت بحرية. إنها تعني، في المقام الأول، الاعتراف بالاختلاف ومنحه حقوقه كاملةً في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. إنها تتجاوز مفهومي الأقلية والأغلبية. فهذه المفاهيم لا تنظر إلى المواطن من منظور انتمائه إلى مجتمع واحد، بل من منظور انتمائه إلى جماعة عرقية أو طائفة أو مذهب أو قبيلة”.
وأضاف: “يُعرَّف الإنسان بإنسانيته، لا بعرقه أو دينه، أو انتمائه إلى أقلية أو أغلبية. ووفقًا لهذه المبادئ، لا يمكن للمسلمين أن يكونوا ديمقراطيين. هناك نوعان من المسلمين: قادة في كل شيء، وتابعون في كل شيء”.