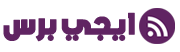محمد فؤاد عضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء: فكرة اللجان الاستشارية جاءت من منطلق التشاركية مع القطاع الخاص

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، إن فكرة اللجان الاستشارية جاءت من فكرة عامة، وهي الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة رؤى مختلفة.
وأضاف فؤاد في حوار مع الشروق، أن لجنة الاقتصاد الكلي تنظر إلى ثلاثة مؤشرات أساسية، الأول هو النمو الاقتصادي والارتباط بين توقعات المؤسسات الدولية وأهداف الحكومة، والمؤشر الثاني يركز على التضخم وما إذا كان سيدخل في اتجاه هبوطي مستدام أم قد يحدث تغيرات، والمؤشر الثالث هو الدين العام وما إذا كان يمكن إدخاله في اتجاه هبوطي.
وترتكز اللجان على توصيات عاجلة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن والبحث عن آليات عمل دائمة.
وأوضح أن اللجان سيكون لها مهمتان في الفترة المقبلة، الجزء الأول سيكون بناء على توصيات عاجلة للوضع الاقتصادي الحالي، والجزء الثاني سيكون لضمان الاستمرارية في عمل هذه اللجان. وفي هذا الجزء لم تتحدد بعد آليات العمل ولم يتضح بعد الدور المستقبلي لعمل اللجان.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية الكلية يمكن أن تكون بمثابة حلقة وصل بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، أي بين التغيرات والمقترحات التي تحدث على المستوى الاقتصادي وأثرها على المواطنين. وأضاف أن لجنة الاقتصاد الكلي لديها مجموعة من الخبرات التي تمكنها من سد هذه المعادلة بين الأكاديميين القادرين على محاكاة التأثير العملي للقرارات على المواطنين، مثل الدكتور. أمنية أمين حلمي، وأعضاء من ذوي الخبرة في المالية العامة مثل د. حسين عيسى، وأعضاء لديهم خبرة أيضاً في مجال الاستثمار مثل حسن هيكل وكريم عوض، بالإضافة إلى أعضاء لديهم معرفة جيدة بسياسات التمويل مثل شريف الخولي، وأعضاء يتعاملون مع الجانب التنفيذي مثل د. مدحت نافع، للإنتاج.
دور اللجنة الاقتصادية الكلية ليس “التنظير” وسنستمع للحكومة أولاً.
وأوضح فؤاد أن دور لجنة الاقتصاد الكلي ليس «التنظير»، وسنسعى للاستماع إلى الحكومة منذ البداية، كما اقترح د. اقترح حسن هيكل ذلك لأننا بحاجة إلى معرفة خطط الحكومة وأرقامها ومؤشراتها. وأضاف: “ليس كل أعضاء اللجنة يتمتعون بنفس القدرة على الوصول إلى المعلومات”.
وعن توقعات التضخم للعام الحالي، يرى فؤاد أن أغلب المؤسسات الدولية تتوقع الوصول إلى مستوى 16% في عام 2025. ومع ذلك، لتحقيق هذه الأهداف، لا بد من توافر البيانات. والأمر الأكثر أهمية هو أن الاستقرار في المنطقة ضروري لتقليل تأثير التوترات الجيوسياسية التي تدفع التضخم إلى الانخفاض. وأوضح أن جزءاً من الانخفاض المتوقع في التضخم خلال شهري فبراير ومارس سيكون بسبب سنة الأساس وبالتالي لن ينعكس على الأسعار. لا ينبغي لنا أن ننخدع بالانخفاض الحاد خلال الشهرين المقبلين، إذ أن معدل التسارع بطيء بسبب سنة الأساس المرتفعة.
وأوضح أنه لا يمكن تجاهل بعض التطورات الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الوقود، لأن مصر تمر بأزمة حقيقية تتعلق بمصادر الطاقة الطبيعية، واستمرار انخفاض إنتاج الغاز، مما يضطر الحكومة إلى إعادة ضبط الأسعار. وحتى لو لم يحدث هذا مع الاستهلاك المحلي، فإنه سيحدث مع الاستهلاك الصناعي، الأمر الذي سينعكس بدوره على الأسعار.
ويرى فؤاد أن الحديث عن الحزم الاجتماعية المتوقعة وزيادة الحد الأدنى للأجور هي وسيلة لعدم تجاهل ارتفاع الأسعار.
إن التضخم والنمو الاقتصادي والديون هي مؤشرات مترابطة، لكن الديون تظل المشكلة الأكثر أهمية.
وفي تعليقه على أزمة الديون، قال فؤاد: “تقديراتي هي أن إجمالي الدين الوطني يبلغ 19 تريليون جنيه مصري، وعبء الدين العام حوالي 13.3 تريليون جنيه مصري، وديون الميزانيات المحلية 9.5 تريليون جنيه مصري، بما في ذلك الديون قصيرة الأجل بقيمة 8.1 تريليون جنيه مصري، والديون الخارجية للحكومة 3.8 تريليون جنيه مصري، وأقدر ديون الكيانات الأخرى التي تضمنها الخزانة بما لا يقل عن 6 تريليون جنيه مصري”.
وأضاف فؤاد أن وزارة المالية تتحدث دائما عن ديون هيئة الموازنة دون النظر إلى إجمالي الدين، وأننا كلجنة اقتصاد كلي مهتمون بتحمل الدين بغض النظر عن مصدره لأنه يخلق عجزا ويجب تمويله بديون جديدة، وهو ما يزيد من مستوى الدين.
وأوضح فؤاد أن المؤشرات الثلاثة “الديون والتضخم والنمو الاقتصادي” مترابطة، “لكن برأيي مشكلة الديون هي الأهم لأنها تثير الكثير من علامات الاستفهام سواء حول إدارتها أو المسؤولية عنها”.
وتابع: “في عام 2017، عندما كنت عضوًا في مجلس النواب، وبالتعاون مع الدكتور وقد أعد زميلي في اللجنة حسين عيسى تعديلاً على مشروع الموازنة. وارتكز ذلك على إعداد تقارير لضمان استدامة الديون مع خطط السداد والمتابعة والحد من الديون وكيفية سدادها بشكل أفضل. كما يجب أن تشمل ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها كلها تعتبر التزامات على الدولة المصرية.
وأضاف أن أي أثر مالي لهذا الإنفاق الكلي أو العجز سيؤثر بطريقة أو بأخرى على بنية الاقتصاد الكلي، ونتيجة للعوائد النقدية الناتجة عن السياسة المالية سيؤثر على معدلات التضخم. وأوضح أن المشكلة الأخرى لأزمة الديون هي وحدة الموازنة، حيث أن نحو 49% من الجهات خارج الموازنة وبعضها يقترض بضمانة وزارة المالية، ما يجعل منها مالكة وليس مسيطرة.
وردا على السؤال المتكرر “متى سيتم سداد ديون مصر؟”، قال فؤاد: “باختصار، الإجابة هي أنه لن يحدث”، نقلا عن الدكتور. تصريح عادل بشاي: “الديون تنتقل ولكنها لا تموت”. والسؤال المتكرر “هل يجب أن تقترض لسداد الدين؟” يجيب عليه أيضا بـ”نعم”، وكل الدول تفعل ذلك.
وأوضح أن هذه الأسئلة لا تستحق المناقشة. والأهم من ذلك هو تخفيض الديون بطريقة مثالية أو إيصالها إلى مستوى آمن. وللقيام بذلك، فإننا بحاجة إلى جداول زمنية وآليات لإعادة هيكلة الديون. وأوضح أن تشجيع الاستثمار من شأنه أن يتغلب على الديون أمام قوة النمو. إن سياسة ضريبية معقولة، مقترنة بزيادة الناتج المحلي، سوف تساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، وهو ما سوف يمنعنا من الشعور بآثار أزمة الديون، وسوف تمكننا من تحقيق فائض أولي حقيقي.
تحولت مصر إلى “اقتصاد ريعي” وأنا استبعد حدوث انخفاض كبير في قيمة العملة في عام 2025.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو وخلق نمو اقتصادي مستدام، استشهد فؤاد بقول د. وقال حسين عيسى إن مصر يجب أن تبدأ بالانتقال من اقتصاد مالي إلى اقتصاد تشغيلي لأن المكون التشغيلي في مصر ضعيف فأصبحنا نعتمد على أسعار الفائدة الأميركية وننتظر الأموال الساخنة لأن الدخل الدولاري يشكل نسبة كبيرة من التدفقات مما يجعلنا اقتصادا ماليا. يمكننا أن نقول إننا أصبحنا “اقتصاد ريعي”، ننتظر عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، ومؤخراً أدخلنا عائدات الديون.
وأوضح فؤاد أن الاقتصاد ينقسم إلى أربعة مكونات أساسية هي: الإنفاق الحكومي، والاستهلاك، والاستثمار، وصافي الصادرات. وأضاف أن الاقتصاد المصري اعتمد خلال السنوات السبع الماضية فقط على الإنفاق والاستهلاك الحكومي، ونحن الآن ننظر إلى الاقتصاد المصري كقائمة من التدفقات.
وفي مقارنة بسيطة أوضح أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر وصافي الصادرات كان أعلى خلال الفترة (2004-2008) مقارنة بالفترة (2019-2023) وبالتالي فإن الديون تسد الفجوة الناتجة عن انخفاض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، وأوضح أن زيادة الديون وزيادة العجز التجاري وزيادة العجز المالي تؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأشار فؤاد إلى أنه رغم الحديث الدائم عن أن الواردات هي مشكلة مصر، فإن متوسط نصيب الواردات من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية هو الأدنى منذ الفترة 1967-1973. وفي عام 2008، بلغت حصة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30%، وفي عام 2023 ستصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف فؤاد أنه بعيداً عن المقارنات، فإننا فشلنا في تحقيق النمو الشامل خلال السنوات الأخيرة. النمو الشامل يعني النمو المبني على خلق فرص العمل، والتنمية الزراعية، والحد من الفقر، والتوزيع العادل للدخل، والتنمية الاجتماعية، والحد من التفاوتات الاقتصادية الجغرافية، والتنمية الصناعية، وحماية البيئة. وأوضح أن وزارة التخطيط مهتمة بتحقيق ذلك.
ويرى فؤاد أن الدولة يجب أن تعود إلى مهمتها الرئيسية وهي خلق سياسة ضريبية معقولة تساهم في نمو الإيرادات وزيادة نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي. وتحتل مصر مرتبة منخفضة في القارة الأفريقية من حيث حصة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتونس والمغرب، اللتين تتصدران الدول الأفريقية في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية يرى فؤاد أن المشكلة تكمن في البطء وعدم التنسيق في الإصلاحات الهيكلية وأنه من الضروري إعادة تفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي أعدته وزارة التخطيط بشكل أكثر تفصيلا وحداثة.
وعن توقعاته بشأن أسعار الفائدة، توقع فؤاد أن نشهد انخفاضاً بنحو 7% خلال العام الجاري. ويرتبط هذا بمعدل التضخم والسياسة المالية وأثرها، وخاصة في حالة ارتفاع أسعار الوقود. وتوقع فؤاد أن يتراوح سعر الصرف بين 50 و55 جنيها خلال العام، وهو ما يستبعد حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة.
وفيما يتعلق بالتوترات التجارية، أشار فؤاد إلى دراسة شارك في تأليفها مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية. ووفقا للتقرير، يتعين على مصر تنويع شركائها التجاريين وتحسين القدرة التنافسية لصادراتها واستغلال موقعها الجغرافي للتخفيف من الآثار السلبية لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد المصري. وتشكل الاستراتيجيات التجارية والصناعية أيضًا عوامل مهمة في تحويل هذه التحديات إلى فرص.
وتوقع فؤاد أن يؤثر تصاعد الحرب التجارية على معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2029. ولذلك، فإننا نحتاج على المدى القريب إلى تنويع أسواق التصدير وإبرام اتفاقيات تجارية مع القطاع الخاص، مع تواجد العديد من الشركات. وعلى المدى الطويل، لا بد من إنشاء قاعدة صناعية محلية، وخاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتحسين إجراءات التخليص الجمركي.