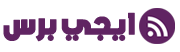الجولة الثانية للمفاوضات بين إيران وأمريكا.. تاريخ طهران في الطموح النووي وصفقات الاتفاق

بدأت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، السبت، في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات حذرة على تحقيق تقدم في البرنامج النووي الإيراني المتوقف منذ أكثر من عامين.
ورغم اللهجة التصعيدية لبعض الأميركيين، فإن إيران تظهر حالياً قدراً من الانفتاح، ولو مع بعض التحفظات. وهذه محاولة واضحة لاختبار جدية واشنطن وإعادة التوازن بين التنازلات والضمانات.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو إن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا تخلت الولايات المتحدة عن مطالبها غير الواقعية وأظهرت نوايا جادة. وبحسب وكالة رويترز، فسر المراقبون ذلك على أنه تحول في الخطاب الإيراني، الذي يعتمد تقليديا على التصعيد اللفظي، نحو نهج أكثر براغماتية.
وتأتي الجولة الثانية التي دعت إليها سلطنة عمان عبر وزير خارجيتها بدر البوسعيدي، عقب محادثات غير مباشرة عقدت السبت الماضي في مسقط. ومثلت هذه المحادثات أول اختبار دبلوماسي بين الجانبين منذ توقف المفاوضات في عام 2021. وفي ذلك الوقت، اشترطت إيران أن يكون أي تخفيف للعقوبات مصحوبًا بضمانات ملزمة تمنع الانسحاب الأحادي من الاتفاق – في إشارة ضمنية إلى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي السابق في عام 2018.
رسالة مزدوجة: يمكن تفسير تصرفات إيران على مستويين
ومن ناحية أخرى، تحاول طهران الحفاظ على هامش تفاوضي مفتوح مع أوروبا وروسيا، وبالتالي اكتساب النفوذ على واشنطن.
من جهة أخرى، يوجه عراقجي رسالة إلى الداخل الإيراني مفادها أن بلاده لا تدخل المفاوضات من موقع ضعف، بل بشروط تحفظ سيادتها السياسية والاقتصادية.
في المقابل، تعكس التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ميلاً نحو عملية تفاوض “صامتة”، على الرغم من التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة إيران إذا فشل الاتفاق. وقال روبيو إن الحكومة الأميركية تسعى إلى حل سلمي لكنها لا تقبل بأن إيران تمتلك أسلحة نووية.
الوساطة الروسية: دعم أم مناورة؟
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من انشغالها بالأزمات الإقليمية، فإن موسكو لا تزال تلعب دوراً فاعلاً في القضية النووية الإيرانية. وأعرب لافروف عن ذلك، قائلاً إن بلاده “مستعدة للتوسط في أي صيغة تؤدي إلى اتفاق يخدم الطرفين”.
عهد الشاه: نشر الأسلحة النووية بالتعاون الغربي، دون قلق الولايات المتحدة
بدأ اهتمام إيران بالطاقة النووية في عام 1957، في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، الذي بادر بالخطوات الأولى للتعاون النووي مع فرنسا، ثم مع الولايات المتحدة، التي زودت إيران بمفاعل أبحاث POOL في عام 1967. ولم يكن هذا الاهتمام المبكر موجهاً نحو الطموحات العسكرية، بل نحو بناء محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
الثورة الإسلامية وحرب العراق: تغيير النوايا وصعود الطاقة النووية كأولويات
وكجزء من التزامها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقعت إيران على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1968 واتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1975، مؤكدة بذلك استعدادها للتعاون الدولي ومراقبة منشآتها.
ورغم أن البرنامج توقف مؤقتا بعد الثورة الإسلامية عام 1979، فقد استؤنف في منتصف الثمانينيات في ظل ظروف الحرب الإيرانية العراقية. وبعد عام 1988، ومع نهاية الحرب وتفكك الاتحاد السوفييتي، شهدت إيران انتعاشاً حقيقياً مع استغلالها للثغرات في السوق النووية والتعاون مع الصين وباكستان وروسيا.
كما أن تطور البرنامج النووي الإيراني استمر في مراحل غير منتظمة وتأثر بالسياقات السياسية والظروف الدولية والإقليمية.
ورغم عدم وجود استراتيجية واضحة في البداية، فإن القضية النووية أصبحت تشكل أولوية قصوى في السياسة الإيرانية منذ تسعينيات القرن العشرين، خاصة وأن طهران أحرزت تقدماً كبيراً في شراء المفاعلات النووية وبناء محطات الطاقة النووية، وأبرزها محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب البلاد.
الألفية: من الانفتاح الحذر إلى الانفجار السياسي
ومع تنصيب الرئيس الأميركي باراك أوباما، تغيرت النبرة الأميركية من التهديدات إلى الحوار، مما أدى إلى الاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015 الذي خفف العقوبات على طهران مقابل التزامات نووية أكثر صرامة.
وقد اعتبر الاتفاق نجاحا دبلوماسيا غير مسبوق في ذلك الوقت، لكنه ظل مصدرا للجدل الداخلي في الولايات المتحدة وخارجها، وخاصة في إسرائيل ودول الخليج، التي رأت فيه غطاء لنوايا إيران المستقبلية.
الألفية: الانفتاح والتصعيد
بدأ التصعيد النووي الإيراني في أغسطس/آب 2002 بالكشف عن منشأتين سريتين لتخصيب اليورانيوم في نطنز وأراك. ودفع هذا إيران إلى الموافقة على عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي عثرت على آثار لليورانيوم المخصب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2003، وفي أعقاب زيارة قام بها وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وعدت طهران بوقف التخصيب. وقد توج ذلك باتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
وفي عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، استأنفت إيران أنشطتها النووية في أغسطس/آب 2005، مما دفع القوى الكبرى إلى إحالة المسألة إلى مجلس الأمن.
وفي إبريل/نيسان 2006، أعلنت إيران عن نجاحها الأول في تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.5%. وفي وقت لاحق، رفضت طلبا بوقف التخصيب وفتحت مصنعا للماء الثقيل.
وفي نهاية عام 2006 فرضت الأمم المتحدة أولى العقوبات إلى جانب العقوبات الأميركية والأوروبية، والتي تصاعدت تدريجيا.
أوباما: بداية الاحتواء ونهاية بالاتفاق
في عام 2009، تواصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع طهران، لكن البلاد استمرت في توسيع قدراتها وفتحت محطة للوقود النووي.
وبعد اكتشاف منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم في فوردو، بدأت إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في عام 2010. وفي عام 2012، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً شاملاً.
وقد غيرت الولايات المتحدة نبرتها من التهديدات إلى الحوار، مما أدى إلى التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015 الذي خفف العقوبات على طهران مقابل التزامات نووية أكثر صرامة.
وقد اعتبر الاتفاق نجاحا دبلوماسيا غير مسبوق في ذلك الوقت، لكنه ظل مصدرا للجدل الداخلي في الولايات المتحدة وخارجها، وخاصة في إسرائيل ودول الخليج، التي رأت فيه غطاء لنوايا إيران المستقبلية.
ترامب: الانسحاب والضغط الأقصى صفعة على الوجه
في عام 2018، وتحت رئاسة دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق لأنها اعتقدت أنه لم يعالج التهديد المركزي الذي تشكله إيران.
وتبع ذلك فرض عقوبات قاسية في إطار سياسة “الضغط الأقصى”، ما دفع إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها واستئناف التخصيب بمستويات أعلى، في حين تزايدت التهديدات بين الجانبين.
ورغم هذا التصعيد، لا تزال إيران تتمسك بخطاب يرتكز على السلطة الدينية ويحرم إنتاج أو استخدام الأسلحة النووية. وتستشهد طهران بفتوى أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تنص على أن “إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، محظور لأسباب دينية”. وباعتبارهم ضحايا سابقين للهجمات الكيميائية، فإن الشعب الإيراني يعتبر حماية البشرية من هذه الأسلحة مسؤولية جماعية.
ورغم أن إيران استخدمت هذه الفتوى كوثيقة أخلاقية في المحافل الدولية، إلا أن البعض شكك في قدرتها على التحكم في الاعتبارات الاستراتيجية طويلة الأمد.