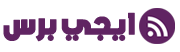باحثة في الحركات البيئية: دول شمال إفريقيا بحاجة إلى 280 مليار دولار عام 2023 لتلبية احتياجات آثار تغير المناخ

زينة منير لـ”الشروق”: المغرب ومصر حصلا على 48% و28% على التوالي من إجمالي التمويل المناخي المعتمد للمنطقة بين 2003 و2023
قالت زينة منير، طالبة دكتوراه في السياسة البيئية من جامعة فرايبورغ في ألمانيا والمهتمة بالحركات البيئية والعدالة البيئية والاتصال البيئي ومفاوضات تغير المناخ الدولية وسياسات التكيف، إن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عقبات مالية كبيرة في جهودها للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وبحسب البنك الأفريقي للتنمية، ستحتاج دول شمال أفريقيا إلى حوالي 280 مليار دولار بحلول عام 2030 لتلبية احتياجاتها في هذا المجال. هناك فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على أصغر حصة من التمويل الدولي للمناخ. على سبيل المثال، في حين تلقت منطقة شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ ما يقدر بنحو 293 مليار دولار من تمويل المناخ في عامي 2019 و2020، تلقت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16 مليار دولار فقط.
وأضاف منير في تصريح لـ”الشروق” أن تمويل المناخ ليس موزعا بالتساوي في المنطقة. وفي حين حصلت المغرب ومصر على 48% و28% على التوالي من إجمالي تمويل المناخ المعتمد للمنطقة بين عامي 2003 و2023، فإن البلدان ذات الأوضاع الأمنية الهشة أو المتأثرة بالصراعات مثل اليمن وليبيا وسوريا لم تتلق سوى أصغر حصة من تمويل المناخ المخصص للمنطقة. وعلاوة على ذلك، تم توفير الجزء الأكبر من هذا التمويل في شكل قروض أو قروض منخفضة الفائدة. ويؤدي هذا الاعتماد المفرط على أوراق الدين إلى تفاقم أزمة الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت إن أزمة الديون المتفاقمة إلى جانب مخاطر المناخ تدفع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حلقة مفرغة. إن المخاطر المناخية المتزايدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الديون الدولية وتحد من الحيز المالي والنقدي للاستثمار في التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود. ومع فشل البلدان الصناعية في الوفاء بوعودها بشأن حماية المناخ، أصبحت التدفقات المالية الدولية المخصصة للتكيف مع المناخ محدودة للغاية، وتجلب معها أعباء جديدة في شكل رسوم خدمة الديون. ويؤدي هذا إلى تفاقم أزمة الديون ويدفع قضية تغير المناخ إلى الخلفية بالنسبة لبلدان المنطقة.
وعندما سُئلت عن أهم التغيرات في النشاط البيئي النسوي في الشرق الأوسط ومدى تأثير هذه الحركات على صنع القرار والسياسات العامة، أوضحت أنه في السنوات الأخيرة، وخاصة في العقد الماضي، كان هناك زيادة حادة في الحركات البيئية التي تطالب بحق المواطنين في بيئة نظيفة. ومن الأمثلة على ذلك حركة “طلعت ريحتكم” في لبنان، والحركة ضد استخراج الغاز الصخري في الجزائر، وغيرها من الحركات الشعبية. وأشارت إلى أنه من اللافت للنظر أن مطالب هذه الحركة لم تقتصر على الحقوق البيئية، بل شملت أبعاداً سياسية واجتماعية. وفي الجزائر، على سبيل المثال، تتشابك الأطر البيئية مع أطر المخاطر الصحية، والإقصاء، والاستعمار الجديد، والعدالة الاجتماعية. وتابعت: “في دراسة الحالة اللبنانية، نجحت حركة “طلعت ريحتكم” في تسليط الضوء بشكل واضح على الفساد السياسي، ليس فقط من خلال لفت الانتباه إلى المخاطر الصحية للقمامة، مع دلالاتها من التعفن والرائحة والمرض، ولكن أيضًا من خلال التأكيد على عجز النظام السياسي الطائفي عن أداء الوظيفة الأكثر أساسية للمواطنين: جمع القمامة بطريقة آمنة وصحية”. وكانت لهذه الحركات تأثيرات اجتماعية وسياسية ملحوظة. وفي الجزائر، على سبيل المثال، أوقفت الحكومة عمليات التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية. وفي لبنان، حققت حركة “طلعت ريحتكم” بعض النجاحات، أبرزها استقالة وزير البيئة المشنوق من لجنة إدارة النفايات الحكومية. وتدرك الحكومة ضرورة جمع النفايات من قبل السلطات المحلية. وتابعت: “لكن الإنجاز الأكثر ديمومة لهاتين الحركتين البيئيتين هو الشبكات والتحالفات الجديدة التي انبثقت عن الحركة مع مرور الوقت، فضلاً عن عدد من القضايا الجديدة التي كانت مخفية في السابق في ظل الصراع الطائفي في لبنان وتهميش مجتمع عين صالح في الجزائر”. . ومن المثير للاهتمام أن الناشطين البيئيين، بما في ذلك النساء، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية في مجتمعاتهم وربط هذه القضايا بالمخاوف السياسية والاجتماعية الأوسع. والأمر الأكثر أهمية هو أن حملة “طلعت ريحتكم” أدت إلى ظهور أحزاب جديدة مثل “بيروت مدينتي”، التي تحدت الأحزاب السياسية القائمة في الانتخابات البلدية في مايو/أيار 2016. ورغم أن التحالف السياسي الجديد لم يفز بالانتخابات، إلا أن دعمه كحزب سياسي ناشئ كان قويا للغاية.وأشارت إلى أنه من اللافت للنظر أن هذه الحركات البيئية الشعبية جذبت اهتمام منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في المجال البيئي وشكلت تحالفات مع المنظمات المحلية. وقد أدى ذلك إلى تنوع الوسائل لرفع مستوى الوعي والتعريف بالمخاطر البيئية في المنطقة. وقد جذب هذا الأمر انتباه مجموعات مختلفة تتجاوز مطالبها الحقوق البيئية لتشمل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تفتقر مفاوضات المناخ في كثير من الأحيان إلى التمثيل العادل للمرأة.وحول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر لضمان تعزيز دور المرأة في هذه المفاوضات على المستويين المحلي والدولي، قالت إن 20% فقط من رؤساء الوفود في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين كانوا من النساء. وهذه زيادة بنسبة 13% مقارنة بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، ولكنها تمثل انخفاضا مقارنة بمؤتمرات الأطراف السابقة. في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لم يكن هناك سوى 15 امرأة من بين 133 رئيس دولة وحكومة شاركوا في المفاوضات.وأضافت أن مشاركة النساء كمندوبات للأحزاب لا يعني أنهن يتمتعن بنفس موقع القوة أو الفرصة للمساهمة بشكل كامل بمعرفتهن ومخاوفهن في مفاوضات المناخ. على سبيل المثال، أظهر تقرير تكوين النوع الاجتماعي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 أنه في حين يمثل الرجال 51% من مندوبي الحكومات، فإنهم يشكلون 60% من المتحدثين النشطين في الجلسات العامة – الاجتماعات التي يحضرها جميع الأطراف – وقد قدموا عروض تقديمية في 74% من الحالات. وقالت إن الافتقار إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة واضح ليس فقط في دوائر صنع القرار والمفاوضات بشأن تغير المناخ، ولكن أيضًا في المناصب القيادية في جميع قطاعات الأعمال والحكومة. في حين أن هناك جهودا متزايدة لإشراك المرأة في مناصب القيادة، إلا أن النساء لا يزالن ممثلات تمثيلا ناقصا بشكل منهجي في مناصب صنع القرار الرئيسية، مما يحد من تمثيلهن في مناقشات الحكومة والقطاع الخاص بشأن سياسة المناخ ومبادرات إزالة الكربون.وتابعت: بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن منطقة الشرق الأوسط لديها أدنى نسبة للنساء في المناصب القيادية (حوالي 10%). وتبدو هذه الفجوة بين الجنسين في القيادة واضحة في مختلف أنحاء المنطقة، ولكنها أكثر وضوحا في ليبيا. ومع ذلك، تشير الدراسات العلمية وتقارير الأمم المتحدة إلى أن الشركات التي تتمتع بتنوع أكبر بين الجنسين في مجالس إدارتها والنساء في المناصب القيادية تكون أكثر احتمالا بنسبة 60% لخفض كثافة استخدام الطاقة، وأكثر نجاحا بنسبة 39% في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأكثر نجاحا بنسبة 46% في خفض استهلاكها للمياه.وأنا على قناعة بأن تحديد حصة محددة لضمان مشاركة المرأة في المناصب القيادية والوزارات والمؤسسات – وخاصة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والاستثمار المناخي – هو أحد السبل لضمان حصول المرأة على مكان في دوائر صنع القرار المحلية وعلى طاولة المفاوضات الدولية. هذا المفهوم عفا عليه الزمن. ويجب سن القوانين والأنظمة وتطوير الاستراتيجيات لضمان وصول تمويل المناخ أيضًا إلى المشاريع المناخية التي بدأتها وتديرها النساء أو المبادرات النسائية حتى تتمكن من قيادة التحول الأخضر في بلدان المنطقة.