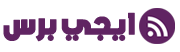“المتحرش لن يُحاسب”.. شهادات حقوقيّات عرب فقدن الإيمان بالعدالة

في العاصمة تونس، بين جدران مركز حقوق الإنسان، تُروى قصص التحرش يومياً، بعضها بأصوات مكسورة، وبعضها الآخر بخجل.
من بين هذه القصص قصة “ريم” – اسم مستعار – التي لجأت إلى مركز الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتخصص في “ضحايا العنف”. كانت تبحث عن ملاذ آمن بعد أن “اغتصبها” مديرها في منظمة دولية لحقوق الإنسان كانت تعمل بها، كما قالت لبي بي سي عربي.
التزمت ريم بحقوق الإنسان بحماس شابة مؤمنة بالتغيير. لكن في مكان عملها، قابلت رجلاً يكبرها بعشرين عامًا. استغل ما وصفته بضعفها النفسي والاقتصادي، وبدأ يتلاعب بها تدريجيًا. تظاهر بالعجز، وتقرب منها متظاهرًا بـ”الإرشاد المهني”، حتى تطور الأمر إلى “اعتداء صريح”.
من المعروف أن التحرش ظاهرة منتشرة في العديد من المجتمعات العربية. وتلعب منظمات المرأة وحقوق الإنسان دورًا هامًا في إنفاذ القوانين التي تحمي المرأة من جميع أشكال العنف، على سبيل المثال، من خلال المساهمة في صياغة قوانين وسياسات مناهضة للتحرش.
هناك اعتقاد عام بأن هذه المؤسسات أكثر أمانًا بالنسبة للنساء لأنها مخصصة للدفاع عن حقوق المرأة أو تستند إلى مبادئ نسوية.
على الرغم من خطابها الحمائي، لا يبدو أن هذه الأماكن بمنأى عن الهجمات والعنف، كما تُظهر الشهادات التي جمعتها بي بي سي العربية. حتى أن بعض النساء تحدثن عن صدمة مزدوجة، إذ وقع الاعتداء في مؤسسة يُفترض أنها “ملاذ آمن”.
وتعتقد آمال خليف، وهي باحثة وناشطة نسوية تونسية، أن حوادث التحرش والانتهاك التي وقعت في بعض هذه المنظمات، على الرغم من كونها صادمة، إلا أنها أدت إلى مراجعات حقيقية، وتطوير سياسات داخلية، وتشكيل لجان، ونشر ممارسات الحماية.
وقال أحد الناشطين الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المنظمات في بعض الأحيان “فقدت شرعيتها” بسبب مثل هذه الحوادث.

“التضامن يمكن أن يقلب الأمور.”
تحدثتُ مع موظفات وناشطات ومحاميات من أربع دول عربية. وأفادن جميعًا بتجارب إساءة معاملة في مؤسسات كان من المفترض أن تحميهن. وتفاوتت ردود أفعالهن، بين الإفصاح عن الأمر وتقديم شكاوى داخلية والالتزام بالصمت. وقد حُجبت أسماء العديد منهن عن هذا التحقيق لضمان سلامتهن.
في هذا البحث، يُستخدم مصطلحا “الناجية” و”الضحية” بالتبادل احترامًا لطريقة كل امرأة في وصف تجربتها. يُفضل البعض مصطلح “الناجية” للتأكيد على القوة والتعافي، بينما يرى آخرون أن مصطلح “الضحية” يُنصف معاناتهن ويُقرّ بحجم الضرر.
وقررت ريم عدم الذهاب إلى المحكمة فورًا، بل أخبرت قصتها بدلاً من ذلك إلى فاطمة أسماء المعتمري، وهي ناشطة نسوية وممثلة الجمعية.
تحدثتُ مع فاطمة، فأوضحت لي أن “القانون التونسي لا يستبعد محاولة الاغتصاب”. لذا، نصيحتها لريم كانت الإبلاغ عن الرجل الذي اتهمته “عندما تكونين مستعدة وراغبة في ذلك”. قالت لها: “نحن هنا. سأكون أول من يدافع عنكِ”.
لم تكن قضية ريم حادثة معزولة. أفادت المتعمري أن المركز تلقى شكاوى أخرى تتعلق بتحرش الرجل نفسه بموظفات في منظمة حقوق الإنسان، واللاتي فضلن، بسبب نفوذه، عدم تقديم شكوى رسمية. كما ذكرت حالات مماثلة لناشطات وموظفات تعرضن للإساءة من قبل أشخاص نافذين، واختارن في البداية الإبلاغ عن الحادثة بشكل غير رسمي بدلاً من تقديم شكوى جنائية.
وفي غياب أرقام دقيقة، تقول المتعمري إن عدد النساء اللواتي لجأن إلى جمعيتها في عام 2024 بلغ 585 حالة عنف، منها أكثر من 80 حالة عنف في مكان العمل.
وتقول إن القرار بالتحدث علناً – دون اتخاذ إجراء رسمي – ينبع غالباً من الخوف وليس من عدم الرغبة في تحقيق العدالة: “الضحية/الناجية تخاف من السلطة وتخاف من عدم تصديقها”.
ولكن في حالات أخرى، اختارت النساء المواجهة.
بعد تردد طويل، تروي فاطمة، قررت ناشطة نسوية مواجهة الرجل الذي اتهمته بالاعتداء. وبفضل ضغط المنظمات النسوية الداعمة، فتحت النقابة التي تعمل بها تحقيقًا داخليًا، مما أدى إلى تشكيل لجنة تأديبية مستقلة. وُثِّقت الشكوى، واستمعت المشتكية، وفي النهاية، بُرئ المتهم.
في قضية أخرى، تلقى مركز جمعية المرأة الديمقراطية شكويين بالتحرش الجنسي من رجل يعمل في منظمة حقوقية. تواصل المركز مع ائتلاف من منظمات حقوقية ونسوية، وبدأ تحقيقًا داخليًا، وشكّل لجنة تأديبية اتخذت إجراءات صارمة، وأدت، وفقًا لفاطمة، إلى فصل الرجل من العمل.
وتقول فاطمة: “لقد ثبت أن مثل هذا التضامن يمكن أن يقلب الموازين، حتى لو كان المتهم قوياً”.
تقول المتعمري: “عادةً ما تصل الضحية إلى مكان الحادث وهي تشعر بلوم نفسها، حتى لو كانت نسوية وواعية. فالصدمة تسلبها مهاراتها التحليلية. لذا، تبدأ مهمتنا بإعادة بناء ثقتها بنفسها، ثم تمهيد الطريق لها لاختيار المسار الذي يناسبها: التعبير عن رأيها، أو خوض نزاع قانوني، أو كليهما”.
على مدى العقدين الماضيين، أحرزت تونس تقدمًا تشريعيًا ملحوظًا في مكافحة العنف الجنسي. وبدأت أولى محاولات تجريم التحرش الجنسي بشكل واضح عام ٢٠٠٤. ويشترط تعريف الجريمة “التكرار والمداومة”، مما يُصعّب على العديد من الضحايا إثبات الاعتداء، حتى لو كان فعلًا واحدًا موثقًا بوضوح.
تغير هذا الوضع عام ٢٠١٧ مع صدور القانون رقم ٥٨، الذي يُجرّم العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك التحرش الجنسي والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب. يلغي القانون مبدأ التكرار، ما يجعل وقوع جريمة واحدة كافيًا لبدء الإجراءات القانونية ومحاسبة الجاني. كما ينص القانون على أن بعض هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. ومع ذلك، يُشير نشطاء المجتمع المدني إلى أن القانون “لا يزال يتطلب آليات إنفاذ واضحة وتدريبًا شاملًا للسلطات القضائية والأمنية على التعاملات الحساسة مع الناجيات”.
هذا مشابه من حيث المبدأ للقانون البريطاني، حيث يُعتبر “التحرش الجنسي” جريمةً منفصلة. لا يشترط تكرار الأفعال، بل يشترط سلوكٌ غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي ينتهك كرامة الضحية أو يخلق بيئةً عدائيةً أو مهينة لها.
ومع ذلك، في حالات التحرش من خلال “المطاردة أو المضايقة المستمرة”، يصنف القانون في المملكة المتحدة سلسلة من الأفعال المتكررة – مرتين على الأقل – على أنها تحرش بموجب قانون الحماية من التحرش لعام 1997.
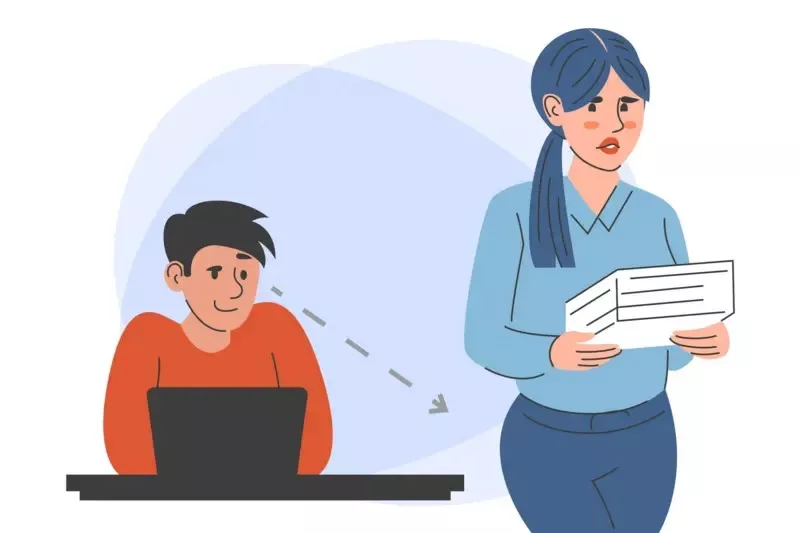
“التوقعات المثالية والصدمات الواقعية”
في دولة عربية، لم تتوقع منظمة نسوية أن صورتها كمكان آمن سوف تتحطم بسبب حادثة تحرش في مكتبها.
وكان المتهم بالتحرش شخصية بارزة في النادي.
قالت إحدى مؤسسات الجمعية لبي بي سي: “كنا مجموعة من النسويات الشابات اللواتي اعتقدن أننا ننشئ مساحة مختلفة. لكننا فجأة واجهنا عنفًا من الداخل”.
لم تكن الضحية الأولى جزءًا من الفريق. وصل بلاغها إلى مجموعة دعم الناجيات، التي أبلغت المنظمة النسوية بالشكوى. تم تعليق عضوية المتهمة فورًا، وتم ترتيب لقاء مع الضحية في مكان محايد. وقالت الناشطة: “لقد تصرفنا وفقًا لمبدأ تصديق الضحية”.
لكن الحادثة لم تمر دون رد فعل. فقد تعرضت الجمعية لحملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي. “اتُهمنا بفقدان شرعيتنا كناشطات نسويات. لكن بعد نشر الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا المزيد والمزيد من الشهادات. شعرت النساء بثقة كافية للتحدث علنًا بعد أن علمن باتخاذنا إجراءً”.
دفعت هذه الحادثة النادي إلى مراجعة هياكله الداخلية. فتم حظر مرتكبها نهائيًا، ووُضع دليل داخلي للموظفين والمتطوعين للتعامل مع حوادث العنف. كما عُيّن مسؤول حماية مُدرّب خصيصًا كجهة اتصال آمنة لتلقي الشكاوى.
تُحذّر الناشطة من مفهوم “الشرعية النسوية” الذي يتبناه البعض لتبرير ممارساتهم. “يدخل البعض إلى الفضاءات النسوية سعيًا وراء الشرعية، ثم يرتكبون العنف من الداخل. حتى أن بعض الناشطات يرتكبن العنف ويدّعين الحصانة لأنهن نسويات”.
في حديثها لبي بي سي حول تجربة تونس، أوضحت آمال خليف أن المنظمات النسوية وحقوق الإنسان في تونس من أهم الجهات الفاعلة في مكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما في ظل دولة أبوية تفتقر إلى نهج شامل ومتكامل. وأوضحت أنه على الرغم من وجود قوانين، تفتقر الدولة إلى رؤية موحدة تجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية، كما أنها لا توفر حماية شاملة للضحايا من النساء. وهذا يُبرز أهمية دور الجمعيات في تقديم دعم شامل يُعنى بجميع جوانب حياة المرأة.
مع ذلك، تُحذّر خليف من النظرة المثالية لهذه المؤسسات. يتوقع بعض المراقبين أن تعمل بكفاءة عالية، مع أنها جزء من المجتمع نفسه والهياكل السلطوية والثقافية نفسها التي تُؤدّي إلى العنف في المقام الأول. وتقول: “المنظمات لا تعمل في عوالم بديلة؛ بل تتكون من أفراد من النسيج الاجتماعي نفسه. ويتطلب التغيير داخلها وقتًا ومراجعة مستمرة للمفاهيم والممارسات”.
وتشير إلى أن “رأس المال الفكري والتجريبي” المكتسب بعد أكثر من عقد من الزمان على الثورات العربية يمكن أن يوفر أساسًا متينًا لإعادة بناء ثقافة مؤسسية بديلة قائمة على الممارسة والنقد، وليس فقط النوايا الحسنة.
وتتفق الباحثة والناشطة النسوية المصرية إلهام عيدروس مع آمال خليف.
وتعتقد أن مجتمع حقوق الإنسان لا يوجد بمعزل عن المجتمع، بل يتأثر بنفس الهياكل الجنسية والطبقية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع ككل.
تقول: “منظمات حقوق الإنسان ليست بمنأى عن العنف. لكنها تتميز – رغم كل شيء – بمستوى أعلى من الوعي، ومحاولات – وإن كانت غير كافية – لتطوير استراتيجيات داخلية لمكافحة العنف”.
وتشير عيدروس، استناداً إلى مشاركتها في لجان التحقيق في العديد من المؤسسات، سواء بصفة إدارية أو كطرف مستقل، إلى أن هذه التدابير يمكن أن تمثل سبلاً للعدالة الإدارية، خاصة عندما تكون السبل الرسمية – مثل اللجوء إلى القضاء – مغلقة أو محفوفة بالمخاطر نظراً للعلاقة المتوترة بين الدولة والمجتمع المدني.
ومع ذلك، تُشدّد على أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي. وتقول: “اللوائح الداخلية مهمة، لكنها لا تُغني عن وجود قانون عادل وفعال ومُلزم للجميع”.

عندما يصبح “وعد الحب” وسيلة للاستغلال
مرة أخرى، أصبح مكان العمل مسرحًا لانتهاك الثقة. هذه المرة في منظمة حقوق إنسان في مصر.
تحت اسم مستعار “دعاء”، تروي شابة مصرية في الثلاثينيات من عمرها قصتها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). انتقلت من بلدة ريفية إلى القاهرة سعياً للاستقلال والنضال من أجل حقوق الإنسان.
في أواخر العشرينيات من عمرها، انضمت إلى منظمة قانونية وحقوقية، والتقت بزميل أكبر منها سنًا يتمتع بشبكة علاقات واسعة ونفوذ كبير في هذا المجال. تقول إنه اقترب منها تدريجيًا بإعجاب مصطنع، ثم بوعود بالزواج. لكنها علمت لاحقًا أن العلاقة الإنسانية التي بدأتها تحولت إلى سلسلة من الاعتداءات النفسية والمادية، بل وحتى الجنسية.
وتقول دعاء إنها لا تفكر في تقديم شكوى رسمية أو طلب تحقيق داخلي، ليس لأنها تشك في تجربتها، ولكن ببساطة لأنها “لا تثق في نزاهة العمليات الحالية”.
“لن يُحاسب”، قالت. “أعلم ذلك جيدًا. إنه يعرف كيف يتهرب من أي مسؤولية، وليس لديّ القوة لمواجهة شخص مثله”.
“خارج الخدمة”
جلستُ في مكتبها بإحدى العواصم العربية، وروت لي محامية تفاصيل قصص عديدة سمعتها خلال عملها. إلا أن إحداها ظلت عالقة في ذهنها، إذ عملت لأربع سنوات متواصلة مع منظمة دولية لحقوق الإنسان في تلك العاصمة.
بدأت القصة بين موظفتين تعملان في المشروع نفسه. تدريجيًا، بدأ المدير الأكبر سنًا بعزلها عن الفريق، طالبًا اجتماعًا مسائيًا، ومدد ساعات عملها بحجج واهية. ثم بدأت المجاملات، التي بلغت ذروتها بمحاولته تقبيلها في المكتب.
عندما قدّمت الفتاة شكوى رسمية، أنكر كل شيء واتهمها بسرقة أفكاره البحثية العلمية. ورغم تحقيق داخلي أجرته إدارة المنظمة، نُقل المدير ببساطة إلى منصب آخر دون أي محاسبة.
لكن التحرش لم يتوقف. بعد نقله، كما تقول، بدأ بملاحقتها إلكترونيًا، وإرسال تعليقات ورسائل لها، واختراق حساباتها. عادت إلى الشركة بشكوى جديدة، لكن الرد كان صادمًا: “ما يحدث خارج بيئة العمل ليس من مسؤولية الشركة”.
“المتهم صديقي”
أفادت محامية تعمل في دولة عربية بتلقيها رسالة من امرأة مرتبكة تتهم فيها رجلاً من مكتب محاماة بالتحرش بها وإرسال صورة فاضحة لها على فيسبوك. ولم تكن هذه شكوى عابرة، بل قالت المحامية إن المشتبه به صديق مقرب لها.
وتقول: “كان من الواضح أن النساء يبحثن عن مكان آمن للتعبير عن أنفسهن، بعيدًا عن الأنظمة الرسمية التي لا توفر لهن الأمان”.
رغم صعوبة الموقف، قررت المحامية أن تضع عواطفها جانبًا. وتقول إن الخطوة الأولى في مثل هذه الحالات تبدأ دائمًا بسؤال بسيط للناجية:
ما الذي تحتاجه؟ هل ترغب بتقديم شكوى؟ هل نبحث عن شهادات مماثلة؟
في هذه الحالة، نشرت الضحية إفادتها مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، أملاً في العثور على نساء أخريات يجرؤن على كسر صمتها. مع مرور الوقت، ظهر نمط متكرر من التحرش والملاحقة، مرتبط بالشخص نفسه. وظهرت إفادات عدة شهود، لكنها لم تكن بلا ثمن.
تقول المحامية إن الضغط الذي واجهته هذه المرة لم يكن من الدولة، بل من المنظمات النسوية ونشطاء حقوق الإنسان. “كان هناك ترهيبٌ صريح. شُكك في مهنيتي، ووُجهت إليّ تهمٌ بانتهاك التضامن لمجرد أنني ساعدتُ الناجيات على التعبير عن آرائهن”.
في مصر، كما في غيرها من الدول العربية، تنتشر شهادات النساء عبر الإنترنت كبديل للقنوات الرسمية. منذ عام ٢٠٢٠، وتحديدًا بعد قضية فندق فيرمونت الشهيرة، ازداد تبادل الشهادات على إنستغرام وفيسبوك وتويتر كوسيلة للتعبير عن التضامن وكسر حاجز الصمت. ويتجلى هذا بشكل خاص في ظل انعدام ثقة العديد من النساء بالإجراءات القانونية، وثقافة الشك السائدة، وصعوبة الوصول إلى العدالة، كما وصفتها لي ناشطات.
“لا أحد يريد اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في بعض الأحيان تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لرفع مستوى الوعي أو منع الآخرين من الوقوع في نفس الفخ”، كما يقول المحامي.
في ظل تزايد تقارير العنف الجنسي ضد المرأة في مصر، برزت مبادرة “دفتر حكايات” كمساحة بديلة. أطلقتها مجموعة من النسويات المصريات المستقلات، وتتيح للنساء فرصة مشاركة تجاربهن مع العنف الجنسي دون خوف أو دليل.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب موجة من الشهادات العامة التي بدأت في يوليو/تموز 2020، عندما شجعت قصص الكشف والتعافي العديد من النساء على كسر صمتهن.
ومع ذلك، يوضح المسؤولون أن الأمر لا يتعلق بالتحقيقات أو المساءلة، بل يتعلق بتزويد النساء بمنصة آمنة للتعبير عن أنفسهن وتوثيق أفعالهن وتقديم الدعم النفسي كجزء من المسار الفردي والجماعي للتعافي.
هل تؤثر دعوى التحرش على البحث عن وظيفة جديدة؟
في إحدى القضايا التي تابعتها المحامية المصرية نسمة الخطيب، اكتشفت أن المدعى عليه في دعوى تحرش سبق فصله من منظمة حقوقية أخرى لارتكابه انتهاكات مماثلة. وعندما تواصلت مع جهة عمله السابقة، أكد المسؤولون ذلك، وأفادوا بأن انتهاء عقده تزامن مع شكاوى تحرش جنسي من زملائه، ولذلك لم يُجدد. ثم قبل لاحقًا وظيفة في منظمة جديدة.
تُوضّح نسمة أن سبب هذه الأحداث هو غياب الشفافية وآليات المساءلة لدى بعض منظمات حقوق الإنسان. وتُضيف:
“لو كانت هناك شفافية، لما تم إعادة تعيينه ببساطة في مؤسسات أخرى تتعامل مع النساء أو تدعي الدفاع عنهن.”
وتستشهد بحالة أخرى تكشف عن “ثغرات مؤسسية في العدالة”: اتُهم ناشط حقوقي بارز بالتحرش الجنسي. أدلى الضحية بشهادته أمام لجنة تحقيق مستقلة مؤلفة من منظمات حقوقية. وخلص التقرير إلى وصف الحادثة بأنها “فعل مشين”. لكن ما حدث بعد ذلك كان صادمًا: اكتفى الجاني بالاعتذار كتابيًا، ثم عاد للظهور في اجتماعات وحوارات نسوية دون تحقيق أو حتى الاعتراف بأفعاله.
تعتقد نسمة أن بعض لجان التحقيق تغفل عن معالجة الانتهاك بالاسم، وتستخدم مصطلحات مثل “السلوك غير اللائق” بدلًا من “التحرش الجنسي”. وهذا يُضعف ثقة النساء بهذه الإجراءات. وتقول: “تشعر العديد من الناجيات بأن التحقيق لا يُنصفهن، فيلتزمن الصمت أو ينسحبن”.
عندما تُغلق الأبواب الداخلية، لا يعود القضاء خيارًا آمنًا، كما تقول نسمة. “اللجوء إلى القضاء محفوف بالمخاطر بطبيعته. ويعود ذلك إلى تعقيد الإجراءات، وضعف إنفاذ القانون، والأهم من ذلك، وجود ثغرات قانونية مثل المادة 17 من قانون العقوبات المصري”.
هذه المادة، كما هو موضح، تمنح القضاة سلطة تخفيف العقوبة وتخفيضها حتى درجتين، حتى في حالات ثبوت التحرش أو الاعتداء. وتنص المادة على أنه في حالات الجرائم الخطيرة، إذا اقتضت ظروف الجريمة تخفيف العقوبة، يجوز للقضاة:
يجوز استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، ويجوز استبدال السجن المؤبد بالسجن المشدد، ويجوز استبدال السجن المشدد بالسجن أو الاحتجاز لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يجوز استبدال السجن بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
تلخص نسمة الوضع بهذه الجملة: “قد يكون الناجي قد بذل كل ما في وسعه: الإبلاغ عن القضية، والإدلاء بشهادته، وتوثيقها، والمثابرة. لكن في النهاية، يقرر القاضي أن الجاني شاب أو من عائلة كريمة، فيخفف الحكم”.
لكن العبء لا ينتهي عند هذا الحد، كما تقول؛ فهناك تكاليف اقتصادية، وضغوط نفسية، وصعوبة تقديم الأدلة. لكن “الأخطر”، في رأيها، هو “ثقافة الشك الجماعية” التي تُجبر العديد من النساء على الصمت أو التحدث فقط في فضاءات نسوية مغلقة، بعيدًا عن المحاكم والمنتديات الرسمية.
هل يجب علي انتظار شكوى رسمية؟
تشير عيداروس إلى نقاشٍ داخل منظمات حقوق الإنسان حول كيفية التعامل مع الشهادات المجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوضح: “عادةً ما تبدأ العملية بشكوى رسمية من الضحية”.
ولكن ماذا لو نُشرت إفادة شاهد مكتوبة دون أن يتقدم الضحية بشكوى؟ هل نتجاهلها؟ أم نفتح تحقيقًا؟
يعتقد عيداروس أن فتح تحقيق شامل دون موافقة الضحية “غير أخلاقي”. ومع ذلك، هذا لا يبرر تجاهل إفادات الشهود، خاصةً عندما تكون متاحة للعامة.
تقول إن ملاحظتها لهذه الثغرة القانونية، وملاحظة زملائها في لجان التحقيق، ساعدتهم على تطوير آليات مرنة داخل بعض المؤسسات، بما في ذلك حزب الخبز والحرية، المنبثق عن التحالف الاشتراكي الشعبي. تتيح هذه الآليات التعامل بمسؤولية مع الشهادات المنشورة دون المساس بإرادة النساء.
وتوضح أن هذه الآليات تعتمد على رصد الشهادات المنشورة، والتواصل مع الشهود – كلما أمكن – لضمان حمايتهم، وتشجيعهم على تقديم شكوى رسمية. وفي حال رفضهم، تُسجل الحوادث في سجل داخلي يُمكن استخدامه لشهادات مماثلة مستقبلًا.
وشددت على أن مسؤولية الإدارات والمؤسسات لا تقتصر على صياغة السياسات فحسب، بل تشمل أيضاً توصيلها بوضوح وضمان سهولة الوصول إليها.
يُشبه هذا النهج النهج المُتبع في المملكة المتحدة، حيث يُشترط قانون المساواة لعام ٢٠١٠ وسياسات الشركات الكبرى، مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن يُتبع أي شكوى أو شهادة عامة بتحقيق داخلي، حتى لو لم يرغب الضحية في تقديم بلاغ رسمي. يُعد هذا التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لحماية الموظفين ومتلقي الخدمات وضمان بيئة آمنة. مع ذلك، تُحترم رغبات الضحية تمامًا؛ فلا تُجبر على المشاركة في التحقيق، بل تُقدم لها خيارات الدعم والحماية. في حال رفض الضحية التعاون، يُسجل ذلك أثناء التحقيق، وتُستمر المراجعة بناءً على أدلة إضافية أو إفادات شهود.

ماذا عن غير الموظفين؟
ويشير عيداروس إلى ثغرة قانونية تعمل في بعض الأحيان على تقويض فعالية هذه السياسات: “معظم اللوائح الداخلية تنطبق فقط على الموظفين، وليس على المتطوعين أو المساهمين الخارجيين، حتى لو كانوا يشغلون أيضًا مناصب قيادية”.
خلال دورة تدريبية شارك فيها بعض الرجال، وردت شكاوى بعد نشر صور تزعم تعرضهم للتحرش أو الإساءة. قطعت الجمعية الاتصال بهم على الفور، وأصدرت تحذيرات للمنظمات الشريكة.
عيدروس يدعو لمقاطعة المنظمات التي تتستر على الجناة: “لا اتصالات، لا بيانات مشتركة، لا تمويل مشترك. الضغط الجماعي له تأثير حقيقي”.
وتختم قائلةً: “نرتكب الأخطاء ونتعلم منها، لكن الأهم هو أن نمتلك أدوات واضحة للردع والمساءلة. لا أحد يملك هوائيات، ولكننا قادرون على بناء آليات حماية فعّالة”.
يبدأ التحقيق داخليًا من قِبل لجنة محايدة تُركّز على الصحة النفسية للمشتكي. وقد يشمل القرار حفظ القضية أو إحالتها إلى القضاء.
يقول أحد المحامين: في منظمة أخرى عقدت ورش عمل، بدأ المشرف بمضايقة المتدربين عبر الإنترنت أثناء ورشة العمل، تلا ذلك رسائل شخصية وإيحاءات رومانسية، تليها تعليقات موحية: “أفتقدك. لم أعد أستطيع تحمل مشاعري”.
وتراجع بعضهم بهدوء، مفضلين الحصار الإلكتروني على معركة صعبة.
وقال العديد منهم لاحقا للمحامي إنهم كانوا يفضلون الصمت من أجل الحفاظ على تعليمهم وفرص العمل في هذا المجال.
في حالات مماثلة، قال المحامي إن الضحايا غالبًا ما يحاولون حجب الأمر أو التزام الصمت. فالإبلاغ يُعرّض سمعتهم المهنية للخطر، بينما قد تُكلّفهم المواجهة وظائفهم أو سمعتهم.

كان الجميع يعرفه، لكن الجميع ظلوا صامتين.
في القاهرة، حيث تمتزج شعارات التحرير بصخب نضالات النساء اليومية في الشوارع، لا تُروى جميع القصص علنًا. بعض القصص تبقى غامضة، ويخشى كاتبوها التعبير عنها خوفًا من العزلة.
نشأت زينة (اسم مستعار) محاطةً بمذكرات الجامعة ونقاشات الحركة النسوية، ونمّت شغفًا بالتغيير والعمل الأكاديمي. لم تكتفِ بمحاضرات العلوم السياسية، بل انغمست في نشاط حقوق الإنسان، والتدريس، والعمل، والمراقبة، حتى بدأت تُدرك ما لا يُوصف.
تقول: “كنتُ أعتقد أن فضاءات حقوق الإنسان والنسوية أكثر أمانًا من غيرها”. لكن مع مرور الوقت، برزت خريطة موازية، تُحددها شبكات وروابط مؤثرة. ودُفنت تصريحات النساء تحت شعارات مثل “وحدة الصف” أو “لا لتشويه الحركة”.
في إحدى المنظمات، وردت شهادات سرية حول الاعتداءات المتكررة على الشابات من شخصيات بارزة، حظيت بالاحتفاء والدعم في المؤتمرات. تقول زينة: “في كل مرة يظهر فيها بيان، تُستخدَم آلة التعتيم. ينكرونه، ويبررونه، ثم يهاجمون الشاهدة أو من صدقوها”.
في أحد تقاريرها، تروي زينة كيف تعرّضت ناشطة لتهديدات خفية من مجتمع نسوي لأنها كشفت عن تجاربها مع ناشط حقوقي اتهمته بالتحرش. وتقول: “كان الجميع يعلم بالأمر، لكن الجميع التزم الصمت”.
ووصفت أسوأ ما في الأمر بأنه “نظام الحماية العكسي”. فبدلاً من حماية النساء، لجأت المؤسسات إلى الصمت والشك، بل وحتى الهجمات الاستباقية أحيانًا. واتُّهم من يتجاوزون الحدود بـ”اتباع أجندة عدائية” أو “التحريض من قبل خصوم سياسيين”.
يُشيطن من يحاولون فضح الانتهاكات. وقد طُرد بعض النشطاء من الميدان، ومُنعوا من المشاركة في المشاريع، وأصبحوا منبوذين.
ما يحدث هنا هو نسخة نسوية من الدولة الأبوية، تقول بسخرية لاذعة. نفس أدوات القمع، ونفس مبررات التعتيم، ولكن بصوت خافت وتفسيرات ثاقبة.